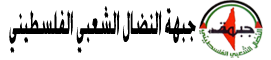القاهرة ـ «القدس العربي»: مع نسائم أعياد الربيع، وفي الوقت الذي يشرع فيه المصريون لشم النسيم، كانت نسبة الهواء الصالح للتنفس في الشارع السياسي صفرا، فقد سنت السلطة أسنانها ومعاولها ومضت عبر أذرعها الأمنية تلاحق كل من يبدي رغبة في نقد النظام، فها هو رئيس تحرير «مصر العربية» عادل صبري آخر من عرف طريق الزنازين في معسكر للأمن المركزي، لينضم لعشرات الصحافيين الذين سبقوه للسجون. ويتوجس آلاف الإعلاميين من ايام حالكة السواد تنتظرهم على الأبواب.
أحمد الشهاوي الشاعر ومدير تحرير «الأهرام» فسّر الحالة بالقول: «في المراحل الانتقالية للأمم يعلو السافل ويتبوأ مكانا ليس له، ويصير المعتوه حكيما، والجاهل مستشارا، والغانية ربَّة ملهمة للشعراء، لأن الأمم وقتذاك تكون في سبيلها للم نثارها والتعافي مما وقع لها، وعلى أصحاب العقول أن ينأوا قليلا ؛ كي لا تفرمهم عجلة الجهل التي لا تدرك ولا ترحم من فرط عتاقتها في الصدأ». أما أشهر كتاب «مصر العربية» و«المصري اليوم» سابقا، سليمان الحكيم، فأوجز المسألة في كلمات معدودات قال: «بالحجب والمنع، أو الحبس، تمنحنا الحكومة شهادة بالشرف. أصبح عليك أن تختار: إما أن تكون صحافيا أو لاجئا أو سجينا!».
خايفين يا ريس
البداية من صحيفة «البديل» حيث يبدي أشرف البربري خوفا شديدا من المستقبل: «في كلمته إلى الشعب بعد إعلان فوزه في الانتخابات قال الرئيس «مصر تسع كل المصريين.. مادام الاختلاف في الرأي لم يفسد للوطن قضية.. والمساحات المشتركة بيننا أوسع وأرحب.. من أيديولوجيات محددة أو مصالح ضيقة.. ولعل العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين.. سيكون على أولويات أجندة العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة». بهذا الخطاب الواضح دعا الرئيس السيسي الناس إلى عدم الخوف من التعبير عن رأيهم بحرية، وقال إن الاستسلام لفكرة وجود ما يمنع الناس من الكلام خطأ كبير، ولكن الأيام القليلة الماضية للأسف الشديد أظهرت أن كلمات الرئيس الواضحة ودعمه الصريح لحرية الرأي والتعبير لم تصل إلى جهات محددة في الدولة فرأينا كيف تم القبض على الزميل عادل صبري رئيس تحرير موقع «مصر العربية» من جانب شرطة المصنفات، بدعوى إدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص، رغم أن عملية المداهمة والضبط جاءت بعد يومين من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتغريم الموقع 50 ألف جنيه، بسبب ترجمة تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» عن الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعني ضمنا، أن الموقع مرخص ويخضع لولاية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبعد ذلك يتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم عديدة. كما رأينا ما حدث في «المصري اليوم» لمجرد نشر عنوان صحافي عن الانتخابات الرئاسية رأت فيه هذه الجهات تجاوزا في التعبير. وقبل ذلك رأينا كيف تم القبض على الإعلامي وائل الإبراشي وحبسه لأنه بث مادة إعلامية اعتبرتها وزارة الداخلية مسيئة لها، قبل أن يتم اخلاء سبيله بكفالة».
موت الملكة خطر عليه
«أزمة الحريات والصحافة وأهلها تحديدا والتخطيط لوئدها ليست في صالح الحاكم، هذا ما سعى محمد علي إبراهيم للإشارة إليه بحذر بالغ في «المصري اليوم»، الأزمة أنك لو قولبت أو وحدت الصحافة سينصرف الناس عنها، إن لم يكونوا قد انصرفوا فعلا إلى قنوات وصحف أخرى. أخشى أن يتحول الإعلام كله إلى نشرة موحدة، كما كان الحال أيام صدام حسين، حيث عملت هناك 3 أيام واستقلت. الآن يتم تسليم المصريين لقنوات الخارج بكل أنواعها وأشكالها بحثا عن معلومة أو تفسير أو حقائق، غير تلك التي يزفها الإعلام الحكومي.. كنت أتمنى أن تمرر الحكومة قانون المعلومات ليتاح للصحافيين حرية العمل والحركة، بدلا من الطريقة السائدة، خسارة المليارات التي تصرف على كل هذه القنوات والصحف التي تزيد الهوة اتساعا بين السلطة والشعب. لا أريد أن نكرر ما حدث لنا أثناء حرب أكتوبر/تشرين الأول المجيدة عندما كنا نبحث عن إحداث ثغرة الدفروسوار في إذاعات لندن وصوت أمريكا ومونت كارلو.. تركتنا صرعى الشك والتخبط بين ما يصوبونه نحونا، والواقع الذي غيبوه عنا. لم نكن قد دخلنا عصر السماوات المفتوحة.. فما بالك الآن وهناك مئات الفضائيات- باستثناء المغرضة المملوكة للإخوان- تحدثنا عن أشياء لا نعلمها. المفروض أن ترد عليهم هيئة الاستعلامات وينشرون الرد، لا أن يعاقبوا الذي كتب أو نقل.. «ناقل الكفر ليس بكافر». انتهت الانتخابات وفازت مصر بالرئيس.. الآن على السيسي أن يستمع لشعبه جيدا، المعارضة ليست خيانة ولكن وسيلة تصويب مشروعة إنسانيا وقانونيا، ولفت نظر للحكومة كي تعرف أن هناك قرارات وآراء اتخذتها ولم تحظ برضا شعبي.. وفق الله الرئيس والحكومة لصالح البلاد والعباد».
لا يليق بمكرم
نتحول بالمعارك ضد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مكرم محمد أحمد ويشنها ضده في «الشعب» عبد الناصر سلامة المستبعد من «المصري اليوم»: «قبل عدة أسابيع استخدم الأستاذ مكرم تعبير «الخونة» في وصف من يقولون بمصرية تيران وصنافير! لنا أن نتخيل أن المواطنين الذين يطالبون بعدم التفريط في الأرض- أي مواطنين وأي أرض- هم الخونة، ومن يطلبون التنازل عن الأرض هم المواطنون الصالحون! لم يحاسبه أحد، على الرغم من أن هذا التصريح أصبح حديث الشارع ومثار تندره، ذلك أن المجلس الذي يرأسه، كما الهيئات الأخرى أصبحت بمثابة سيف أمني مسلط على رؤوس وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وليست هيئات داعمة للعمل الإعلامي، وإلا لما تم إغلاق عشرات، بل مئات المواقع الإخبارية، لمجرد أنها ليست على هوى النظام، ومن ثم هوى القائمين على أمر الإعلام، وإن كان معظمهم ليسوا على دراية بأسباب ذلك، ولا بالجهة التي تقف خلف هذه الإجراءات. أعتقد أنه بدءا من الآن لا يجوز للأستاذ مكرم ولا لمجالسه محاسبة من يتفوهون بألفاظ نابية في وسائل الإعلام، لا يجوز لهم عقاب أحد ولا مجرد استدعاء أحد، لا يجوز لهم التشدق بالقيم والأخلاق والمثالية، لا يجوز لهم حتى تطبيق القانون واللوائح في هذا الشأن، ذلك أن فاقد الشيء لا يعطيه، لنطبقه أولا على أنفسنا، ننتظر من أحد أعضاء المجلس الأعلى للإعلام أو بعضهم، التقدم بمذكرة رسمية يطلبون فيها التحقيق مع الرجل، أو أن يطلب هو بنفسه التحقيق، إلا أن كل ذلك في نهاية الأمر سوف يكون انتقاصا من قدره في هذا العمر وهذه الشيبة.. لذا عليه أن يفعلها هو بشجاعة أدبية ويستقيل، إفعلها يا أستاذ مكرم».
عدنا كما بدأنا
فاجأتنا سوزان حرفي في «البديل» بالمحنة التي نعيشها حيث: «تبقى الأسئلة قبل الانتخابات كما بعدها، بدون إجابة شافية، ولا معلومات تقول إلى أين نحن ذاهبون، ولا الجديد الذي تحمله السنوات الأربع المقبلة؟ وهل ستبقى أربع سنوات؟ أم سيطالها تغيير في مدة الولاية أو عدد فترات الرئاسة، أو كليهما معا؟ فقط يأتي الحديث عن حراك سياسي منشود، ونشاط حزبي مقبل، لعدم تكرار «أزمة» انتخابات 2018، كتطييب للخواطر؛ بدون التطرق للأسباب الفعلية للأزمة ولا لطبيعتها؛ فالدولة تعتبر نفسها نجحت في تحقيق ما أرادت، سواء على مستوى المرشحين أو نسب المشاركة. على خلفية هذا النجاح، وبوسائله وآلياته نفسها تتجه للخطوة التالية، وهي الانفتاح السياسي الذي حان وقته كرافعة للقرارات الاقتصادية ودفعا لعجلة الاستثمار، والمدقق يستطيع أن يرى الساحة السياسية والفاعلين فيها وأين سيقفون، وطبيعة السياسيين ودور النخبة القديمة في اللعبة الجديدة، فقد أتت أشراط الإجابة في مشاهد ثلاثة. أولها صورة الرئيس في مقر حملته الانتخابية أثناء إعلان النتيجة، فلقد بدا محاطا بأعضاء البرنامج الرئاسي وممثليه في مؤتمرات الشباب، وغابت كل الوجوه القديمة، سواء كانوا ساسة أو مسؤولين، ثم منصات الاحتفال التي تكفل بها وتصدرها نواب ورجال أعمال، كجزء من المشهد الثاني، الذي يكتمل بمقرات فخمة انتشرت في ربوع البلاد لـ«ائتلاف دعم مصر». الائتلاف يطرح نفسه كحزب حاكم، وليس تحالفا انتخابيا يحوز أكثرية مقاعد البرلمان الحالي، ويطمح لحصد الأغلبية فيما هو مقبل، بدون أن يرتبط ذلك بتأييد شعبي أو حضور جماهيري، فالفوز في الانتخابات أصبح رهين حسبة «التربيطات» وتوفر المال والعصبيات، رغم ذلك فإن الشواهد تدل على أننا أمام أبطال المسرح المقبل، هؤلاء هم الطبقة والنخبة السياسية الجديدة، نخبة لم يفرزها التفاعل الطبيعي، نخبة مصنعة سابقة التجهيز».
عليه أن يدرك الحقيقة
يرى طارق عبد العال في «الشروق»: «أن وجود مثل هذا العدد من الأصوات الباطلة، في الانتخابات الرئاسية لم يكن أمرا عبثيا أو نتيجة لعدم إدراك كيفية التصويت، خصوصا أن هذه الانتخابات لم تشهد غير مرشحين اثنين، وهو الأمر الذي يجب معه استبعاد الأخطاء عند النظر إلى هذه الأصوات الباطلة، وهناك العديد من الاحتمالات وراء هذه الظاهرة من الناحية الحيادية، أولها إدراك الناخبين أنه لا طائل من التصويت لأي من المرشحين، على اعتبار أن النتيجة محسومة لصالح الرئيس الحالي، والسابق، أو المرشح رقم واحد، ومن الأخطاء أيضا ألا ننظر إلى ما تم في أثناء العملية الانتخابية ودور المال السياسي فيها ــ وقد سبق أن أوضحت ــ كما تناولته معظم المواقع الإخبارية من تصريحات للعديد من المسؤولين البارزين في الدولة مثل المحافظين ونوابهم، التي أظهرت المال بشكل مباشر، مثل تقديم خدمات بمبالغ محددة للقطاعات أو المناطق الأكثر تصويتا، بخلاف الدور الذي لعبه رجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب المصري، ومن ثم فإن هذه العوامل مجتمعة مع غيرها كان لها تأثير في ظهور هذه النسبة الكبيرة، التي فاقت ما حصل عليه المرشح الثاني لمنصب الرئاسة، ومن خلال هذا المدخل نستطيع أن نؤكد أن هناك العديد من المطالب الشعبية التي يجب على السلطة التنفيذية السعي الجاد نحو تحقيقها، واجتياز العديد من الصعوبات التي طالت حياة المواطنين في العديد من القطاعات، التي يأتي في مقدمتها المطالب الاقتصادية، إذ أن الشعب المصري قد عانى كثيرا من تردي الأحوال وزيادة نسبة الفقر وارتفاع أسعار معظم السلع التموينية ومتطلبات الحياة اليومية للمواطنين، إضافة إلى الغلاء الذي طال الخدمات الأخرى مثل شهادات الميلاد أو المستخرجات الحكومية بشكل عام».
نعمة أم نقمة؟
«لا يجد مرسي عطاالله في «الأهرام» سببا يبرر هبوب هذه العاصفة «الملغومة» متعددة المصادر والشخوص، وبتسلسل زمني متقارب تحت غطاء الدعوة لتنقية الأجواء السياسية، بما يسمح بإمكانية إعادة الجماعة والمتعاطفين معها للمشهد السياسي مرة أخرى بصورة أو بأخرى، وكأننا نسينا تماما أن مثل هذه العواصف الملغومة هبت علينا مرارا من قبل في سبعينيات السادات وتسعينيات مبارك، وابتلعنا الطعم وقتها للأسف الشديد بحسن النيات التي رجحت كفتها على ضرورات الحذر والفطنة السياسية الواجبة، فكان ما كان من أحداث المنصة واغتيال السادات في 6 أكتوبر/تشرين الأول عام 1981، وكذلك جرائم الإرهاب البشعة التي بلغت ذروتها ضد السياح الأجانب في مدينة الأقصر عام 1997. إن الحديث عن فتح أبواب المصالحة والحوار، يعني رغبة في إحداث شرخ في جدار الجبهة الوطنية المتماسكة منذ 30 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز و26 يوليو عام 2013.. خصوصا أن أي مراجعة لسوابق العمل والتعامل مع هذا التيار تجعلنا أمام مشهد مصطنع يراد له أن يتكرر كصورة طبق الأصل، وكأنها روايات تعاد حكايتها بالتفاصيل نفسها. إن من العبث أن يغيب عن أذهاننا للحظة واحدة أننا عشنا من قبل تجارب مماثلة وتعرضنا بسبب الإفراط في حسن النية والتخلي عن ضرورات الحذر والفطنة السياسية إلى مخاطر جسيمة في ما بعد، فهل لدى من يطرحون مثل هذه السيناريوهات مجددا أي ضمانات مؤكدة، تجعلنا نستبعد من حساباتنا أن الغد لن يحمل مخاطر مشابهة لمخاطر الماضي؟ هذا هو السؤال وجوابه هو القول الفصل في التعامل مع هذه العاصفة التي تستلزم أقصى درجات الحذر».
هل تعتذر الأهرام؟
الحرب ضد مؤسسة «الأهرام» مشتعلة والأسباب يوضحها أنور الهواري رئيس تحرير «المصري اليوم» الأسبق: «إذا كان لا يزال لدى مؤسسة الأهرام من قيم تتفاخر بها، عليها أن تقدم اعتذارا للكاتب الصحافي طارق حسن، وتعيد له اعتباره كابن مخلص لها وصحافي قدير، على الأسلوب المسيء والطريقة الوضيعة التي تعاملت بها معه إبان ثورة يناير/كانون الثاني، التي تتعارض مع كل الاعتبارات المهنية والإنسانية والأخلاقية والقانونية، وتم اضطهاده لا لشيء الا لثباته وإيمانه بمواقفه – حتى إن اختلفنا معه في بعض منها – وتحول المتلونين والمنبطحين والمداحين والمخبرين، الخ إلى ثوار ومصلحين، وكأن الأهرام كانت خلية ثورية سرية في زمن مبارك، ونحن لا نعلم، والوحيد الذي يقف في طريق الثورة طارق – سألته كثيرا في لقاءاتي معه عن السر وراء ذلك، خاصة بعد ما رأيت بعيني حقارة المكان الذي تم تخصيصه له، فكان يكتفي بابتسامة ساخرة تحمل الكثير لكنه لم يعلق. أشهد له ـ وصداقته سنوات طويلة بعد عودته من غزة عن طريق صديقي العزيز جلال نصار وعزت إبراهيم وهو بدوره عرفني بكثيرين من قيادات الفلسطينيين والكتاب والصحافيين ـ بأن روحه سمحة متسامحة وإنسانيته رحبة جدا ويمتاز بخفة ظل وروح نقدية عالية بجانب تميزه وحبه لعمله، الله يرحمك يا طارق هناك كثير أحياء لكنهم أموات وهناك كثير أموات لكنهم أحياء سلام لروحك ونفسي حزينة جدا لفراقك».
لهذا تخلفنا
«لماذا تخلفنا كثيرا حتى تحجرت عقولنا وأصبح فكرنا محدودا؟ يتساءل كريم خالد في «اليوم السابع»: سبقتنا المجتمعات الغربية وتحدت الزمان وبرعت في الفلسفة والتربية والعلوم، حتى أصبحت في وقت قصير أعظم منا فكريا وثقافيا وإنسانيا.. أما نحن فمجتمعنا الشرقي نسي أصله العظيم وانتكس حتى ضاقت عقول أهله، وأصبح مجتمعا لا يرحم، أصبحنا نعيش، نحن الشرقيين، في مجتمع قاس في نظرته وحكمه على الناس، مجتمع عنصري لا يقبل الاختلاف ولا يعترف إلا بالأغلبية ويرفض ويهمش الأقلية، كأننا نعيش في غابة يأكل القوي فيها الضعيف، في الماضي كنا نتحلى بالأخلاق، وكنا محافظين، لكن في الوقت نفسه كنا متحررين ومواكبين للعصر، أما الآن فتخلفت عقولنا وماتت إنسانيتنا.. المجتمع الغربي وصل بعلمه وتطوره إلى زراعة رأس بشرية كاملة في جسد آخر، أما المجتمع الشرقي فأصبح يقطع الرؤوس ويمثل بالأجساد.. الغرب وصلوا إلى القمر والمريخ وبحثوا في إمكانية الحياة على كوكب آخر غير الأرض، أما الشرقيون فأصبحوا لا يفكرون إلا في الشهوة والجنس.. في الغرب تعلي القوانين المدنية من شأن المرأة وتعطيها حقوقها في الطلاق والانفصال عن الزوج، أما المجتمع الشرقي فينظر إلى المرأة المطلقة باعتبارها فاجرة أو عاهرة. للأسف أصبح مجتمعنا الشرقي أبعد ما يكون عن حضارتنا وإنسانيتنا، ولم يعد فكرنا المحدود يلائم عمق وعظمة ثقافتنا وتاريخنا، حتى ديننا، أخطأنا فهمه وتفسيره فتطرفنا باسمه وشوهنا صورته أمام العالم الغربي».
«أدي الربيع عاد من تاني»
شم النسيم يتساوى فيه الأغنياء والفقراء،ليس مثل عيد الفطر أو عيد «الأضحى» يتطلب الاحتفال به أموالا كما يرى يوسف القعيد في «الأهرام». الأول لعمل الكعك. والثاني لذبح الأضحية التي يتداخل فيها البُعد الديني الإيماني. والقدرة المالية. ما يجعل العيدين فيهما بعض التميز الطبقي. شم النسيم يكفي أن يكون عندك سردين أو فسيخ أو ملوحة. ومعها لوازمها من البيض. والألوان المتاحة. والبصل الأخضر والخس والخبز المصنوع صباحا. كانت قريتنا محصورة بين فرع رشيد وترعة ساحل مرقص. وفرع رشيد أحد فرعي النيل. هنا تتفاوت الأحوال حسب القدرات المالية. من يستطيع أن يستقل صندلا أو مركبا أو سفينة. ويعبر للناحية الأخرى، حيث محافظة الغربية يفعل. ومن لا يستطيع أمامه أحد أمرين. إما أن يعبر نهر النيل سابحا مُستعرضا قدرته على العوم، التي لا يتمتع بها باقي أهالى القرية، فعملهم الزراعة والفلاحة. ينسى لحظتها أخطار البلهارسيا وأعراضها ومضاعفاتها. جريا وراء استعراض القدرة على السباحة. والباقون يقضون يومهم على شاطئ النهر ما بين زردة الشاي وتدخين المعسل وتناول وجبة شم النسيم».
نتنياهو الجزار
ومن شم النسيم إلى التنديد بنتنياهو على يد مصطفى يوسف اللداوي في «الشعب»: «لا يستحي رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عندما يصف جيش كيانه بأنه من أكثر جيوش العالم مناقبية وانضباطا، ومن أكثرها التزاما بالأخلاق العامة، وأشدها حرصا على حقوق الإنسان، ولهذا فقد هنأ جيشه على ما قام به جنوده على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بعد المذبحة التي ارتكبها جيشه الأخلاقي بحق السكان العزل، الذين خرجوا في مسيرة سلمية لا سلاح فيها ولا متفجرات، ولا قنابل ولا بنادق، ولم يقتربوا من الأسلاك الشائكة التي تبعد عن جنودهم عشرات الأمتار، ومع ذلك فقد افتخر بهذا الجيش النظامي الذي قتل خمسة عشر فلسطينيا، وأصاب بجراح أكثر من ألف وخمسمئةٍ منهم، إصابة بعضهم خطرة، وكانت قيادة جيشه قد استجلبت عشرات القناصة الذين تنافسوا في إظهار براعتهم واستعراض مهارتهم في قنص الشبان والشابات، الذين خرجوا مع أسرهم وأفراد عائلاتهم، بدون أن يكون في أيديهم حجارة أو أي شيءٍ آخر قد يخيف جنود الاحتلال. لست أدري هل يضحك نتنياهو على نفسه؟ أم يكذب على جيشه؟ أم يخدع المجتمع الدولي؟ أم يحاول أن يطمس الحقائق بلسانه ويمحوها بكلامه؟ أو يوهم نفسه بما تخرف؟ عندما يتبجح بهذه التصريحات، ويتشدق بهذه الأوصاف التي تخالف الحقيقة، وتتنافى مع الواقع، وتكذبها الأحداث والأرقام والصور والوثائق والشهود والمستشفيات، ويدحضها إعلامهم ومستوطنوه، الذين رفض بعضهم تصريحاته، وكذب شهادته، ونفى روايته، وأنكر المبررات التي ساقها واستعرضها لتشريع القتل وجواز القنص. نحن لا ندعي عليهم ولا نفتري، إلا أن انتقاده هذه المرة جاء على لسان الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي يقول «الجيش الإسرائيلي الذي يطلق النار من الدبابات، ومن قبل القناصين، على متظاهرين ليسوا مسلحين، وهم خلف الجدار، ولا يهددون حياة الجنود، ويتفاخر بقتل فلاحٍ في أرضه، هو جيشٌ يقوم بمذبحةٍ».
الحج للقدس
يأخذنا محمود خليل في «الوطن» وبمناسبة ما يتعرض له القدس الشريف من مخاطر لطرح قضية لطالما اهتم بها المجتمع المسلم: «كان ثمة حكمة بليغة وراء هذا التوجه النبوي، نستطيع فهمها إذا أخذنا في الاعتبار أن بعض المسلمين لم يترددوا في الحج إلى بيت المقدس عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتار القارئ لكتب التراث وهو يتوقف أمام حكايات ومواقف متناقضة ترويها حول موقف خلفاء النبي – صلى الله عليه وسلم- من مسألة شد الرحال إلى المسجد الأقصى، كما تشد الرحال إلى البيت الحرام. دعونا نستشهد في هذا السياق بمواقف متناقضة تحكيها كتب التراث عن موقف عمر بن الخطاب من هذه المسألة. يذكر كتاب «كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال»: عن سعيد بن المسيب قال: استأذن رجلٌ عمرَ بنَ الخطاب في إتيان المسجد الأقصى، فقال: إذهب وتجهّز فإذا تجهزت فأعلمني، فلما تجهز جاءه فقال له عمر: إجعلها عمرة، قال ومر رجلان وهو يعرض إبل الصدقة فقال لهما: من أين جئتما؟، قالا: من بيت المقدس، فعلاهما بالدّرة، وقال أحج كحج بيت الله، قالا: إنما كنا مجتازين». يبين ما يحكيه سعيد بن المسيب أن عمر تبنّى موقفا صارما من هذا التوجه الذي ظهر بين آحاد من المسلمين بالترخص في قصد المسجد الأقصى، كما يقصد البيت الحرام. في المقابل من ذلك يحكى ابن كثير في «البداية والنهاية» موقفا مناقضا يذكر فيه: «ويقال إنه – يقصد عمر بن الخطاب- لبّى حين دخل بيت المقدس، وصلّى فيه تحية المسجد بمحراب داود وصلى فيه بالمسلمين صلاة الغداة من الغد». ولفظ «يقال» الذي استخدمه ابن كثير يجعلنا نتردد في قبول روايته، فكيف نقبل منطقيا أن يلبّي عمر وهو داخل إلى بيت المقدس وكأنه على أبواب مكة؟».
وما يخدعون إلا أنفسهم
هناك من هو مستعد أن يخدع نفسه، ويخدع الآخرين، بفرصة سلام ممكنة.عبد الله السناوى وكأنه يلمح لولي العهد السعودي وآخرين في «الشروق»: «الأسوأ أن هناك من هو مستعد لتبني الرواية الصهيونية. عشرات الدروس على مسار الصراع يتم إهدارها الآن على نطاق غير مسبوق، كأن القضية الفلسطينية بلا ذاكرة. ضاع درس أن الصراع في جوهره بين مشروعين: «القومي العربي» و«الصهيوني» ــ انكسر الأول وتوحش الثاني. ضاع معنى أن فلسطين نفسها قضية العرب المركزية حتى أصبحت عبئا على أغلب النظم العربية تطلب التخلص من صداعها. أسوأ ما يحدث تطبيع العلاقات الاقتصادية والاستخباراتية والعسكرية مع إسرائيل ودمجها في الإقليم مجانا، بدون التزام بمنطوق مبادرة السلام العربية، التي تقضي بتطبيع كامل مقابل انسحاب شامل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام (1967). منذ توقيع اتفاقيتي «كامب ديفيد» كان التطبيع السياحي والثقافي من بين الاشتراطات الأمريكية، حتى يكون دمج إسرائيل في المنطقة مقبولا ومعتادا وطبيعيا، لكنه فشل بقوة الرأي العام المصري. وكان التطبيع التجاري مطلوبا ــ بذاته ــ كمدخل لبناء شرق أوسط جديد على أنقاض النظام الإقليمي العربي. وكان التطبيع العسكري والاستخباراتي، ما هو معلن وغير معلن، الهدف الأعلى للمشروع الصهيوني إذ تتقوض به أوضاع صراع وتبنى أوضاع سلام ــ بدون أن يكون هناك سلام يقر للفلسطينيين أي حقوق مشروعة. الأخطر في مثل هذا النوع من التطبيع أنه يحتفظ لإسرائيل بالتفوق النوعب العسكرب، على كل الدول العربية مجتمعة. عند إحدى ذروات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قال مثقفون عرب: «دعوهم يحلون قضيتهم، فلستم أكثر فلسطينية منهم». رغم أن ذلك الطرح ينطوي على قصور فادح، فالقضية الفلسطينية مسارا ونتائج لم تخصهم وحدهم في أي وقت، إلا أننا لو قبلناه فرضا لجاز الاعتراض عليه من موقع الوطنية المصرية لا القومية العربية. الترجمة العملية لسلام القوة دفع الدور المصري إلى التهميش الكامل لصالح المشروع الصهيوني. عند الاختيار بين دور طبيعي وتاريخي تلعبه مصر، وقد لعبته في مراحل عديدة من تاريخها، وبين دور لا طبيعي ولا تاريخي تلعبه إسرائيل إن دمجت في المنطقة على النحو الذي يخطط له، فإن الاختيار يجب ألا يكون فيه أدنى التباس أو تردد».
سامحونا
«ما حدث في مدينة دوما حسب جمال سلطان في «المصريون»، شيء خارج تصور العقل في معارك ما بعد الحرب العالمية الثانية، عندما قصف جيش بشار الأسد المدينة بالأسلحة الكيميائية، وتعمد إسقاط البراميل الحاملة لغاز السارين والكلور على الأماكن التي توجد فيها ملاجئ للأطفال والنساء يحتمون بها من الصواريخ والمدفعية، ما أدى إلى إصابة أكثر من ألف وخمسمئة، منهم حوالي مئتي قتيل حتى الآن، وكانت الفيديوهات التي نقلتها وكالات الأنباء العالمية لصور جثث الأطفال والرغاء الأبيض يخرج من أفواههم وأعينهم مشهدا مخيفا، يذيب القلوب، ويستحيل أن يوجد إنسان ـ بقي إنسانا ـ ولا يتحرك قلبه لهذه الوحشية التي يستخدمها الطاغية المجرم بشار الأسد ضد الشعب السوري، لمجرد أنه طالب الحرية والكرامة. بابا الفاتيكان مشكورا أبدى استنكاره الشديد للجريمة، ووصفها بأنها «عملية إبادة غير مبررة ضد سكان لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم»، وهو اتهام نادر الصدور عن الفاتيكان، من هول الجريمة وبشاعة الصور الحية التي نقلت للعالم كله، وكنت أتمنى أن يسبق الأزهر والمراجع الدينية الإسلامية في العالم العربي والإسلامي بابا الفاتيكان في إدانة هذه الهمجية، التي يمارسها نظام بشار الأسد الوحشي، الذي يبدو وكأنه مقبل من ظلام العصور الوسطى. أما الجامعة العربية وأغلب الحكومات العربية فلا تنتظر منها شيئا، بل أن بعضها ربما كان سعيدا لأن بشار عندما «يؤدب» شعبه الثائر من أجل الحرية بكل تلك الوحشية، فإنما يرسل من خلاله الرؤساء العرب رسالة التحذير إلى شعوبهم إن فكرت أن تتمرد عليهم، أمامكم الدرس فاتعظوا!».
لن ينقذهم ترامب ولا خدمه
نبقى مع المأساة السورية وطه خليفة في «المصريون»: «توعد ترامب نظام بشار بأن يدفع ثمنا باهظا لهجومه المتهور بغاز الكلور السام على المدنيين، وبينهم نساء وأطفال في مدينة دوما في الغوطة الشرقية. لم يقل لنا ما هو الثمن الذي سيدفعه وكيف ومتى؟ وقد كان هو شخصيا ـ ترامب ـ سببا رئيسيا في هذا التهور والحماقة والتوحش، عندما أعلن عن قرب انسحابه من سوريا ليتركها فريسة لبوتين وإيران. الأطفال الذين قتلهم بشار بالغاز السام في دوما لم يكونوا قد خرجوا للحياة عندما اندلعت الثورة السورية. قدر الله لهم أن يأتوا.. ثم يتخلص منهم هذا النظام المتوحش بأبشع أنواع القتل، ويقف العالم متفرجا على ما يجري. دمشق وموسكو وطهران تدرك أن العجز بلغ مداه عربيا وعالميا، وأن واشنطن في عهد ترامب تمر بأسوأ عهودها وفي طريقها لتنتهي كدولة عظمى، لتذوق الكأس نفسها التي شرب منها الاتحاد السوفييتي. تاريخيا.. لا توجد قوة عظمى مخلدة. امبراطوريات كبيرة سقطت وانتهت، ويبدو أن ترامب سيكون أشبه بغورباتشوف هذه المرحلة بالنسبة للولايات المتحدة، مع الاختلاف بأنه كان يسعى لإسقاط الأسوار الحديدية الشيوعية والانفتاح على الحريات والديمقراطية. ترامب عكسه تماما، يتخلى عن كل المبادئ وقيم الليبرالية التي قامت عليها دولته العظمى، متحولا إلى سمسار يجني الأموال من هنا وهناك. حارس بدرجة «قبضايا» لمن يدفع، وإلا سينزوي إلى داخل حدود بلاده. لا نعتقد أن بشار سيدفع أي ثمن سوى بضعة صواريخ قد ترسلها واشنطن ذرا للرماد في العيون، كما حدث في العام الماضي، ردا على محرقة خان شيخون. إيران وروسيا تعرفان أن ترامب عاجز تماما».
أبطال المسرح السياسي القديم ابتلعهم النسيان والسيسي يؤسس لنخبة على مقاسه