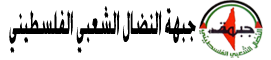خلال نزهة على الأقدام في لندن بعد الهدنة في 1 كانون الأول (ديسمبر) 1918، استدار رئيس الوزراء الفرنسي في زمن الحرب، جورج كليمنصو، إلى نظيره البريطاني، وسأل:
“ماذا تريد؟”
“الموصل”، أجاب للويد جورج.
“ستكون لك”، أعلن كليمنصو. “وماذا أيضاً؟”
“فلسطين”.
“ستكون لك أيضاً”.
إذا سرت صاعداً التل من محور المواصلات المسمى “الكولا” في بيروت -المدينة التي ما تزال واجهات مبانيها تحتفظ بالثقوب التي أحدثها القتال خلال سنوات الحرب الأهلية 1975-1990- فإنك ستمر بالمباني البالية بعض الشيء للجامعة العربية اللبنانية. وعلى يسارك، سترى ملعب البلدية الرياضي القديم؛ حيث تم تعذيب الأسرى الناجين من مذبحة صبرا وشاتيلاً التي نفذتها قوات الكتائب اللبنانية تحت إشراف إسرائيلي. ثم، على بعد بضعة مقاطع سكنية عبر الشارع، ستصل إلى بوابة متواضعة تفتح على واحدة من أكثر البقاع خضرة وهدوءا في بيروت: “مقبرة الحرب البريطانية”.
هنا، على أرضيات مشذبة العشب، دفن ضحايا الإمبراطورية البريطانية في حملات غرب آسيا في الأعوام 1914-18، إلى جانب أعداد أصغر من القبور التي أضيفت لاحقاً من قتلى المناوشات الأصغر نسبياً خلال الحرب العالمية الثانية. ومقبرة بيروت هذه هي واحدة من 23.000 مقبرة ونصب تذكاري، منتشرة في 154 بلداً، تشرف عليها لجنة مقابر الحرب التابعة للكومونويلث، بما فيها العشرات في الشرق الأوسط، والتي تمتد من الخرطوم إلى القاهرة إلى دمشق وبغداد وطهران.
كما يليق بالعقلية الكولنيالية، لم تُعامَل كل القبور بالتساوي. فقد تميزت قبور القتلى من بريطانيا وحلفائها البيض من الكومونويلث بشواهد قبور فردية جميلة، ومزروعات من الورود التي تتم رعايتها بعناية. أما الهنود والعرب، الذين قاموا بمعظم القتال وقتلوا خلال الحملات الإمبريالية في الشرق الأوسط، فقد دفنوا في قبور جماعية مجهولة، والتي تم تمييزها بعد سنوات لاحقة فقط بإقامة نُصب مفصولة عن قبور البيض بعناية: “الجنود الهندوس في الجيش الهندي” هنا؛ “الجنود المسلمون” هناك. وفي مكان منفصل بعض الشيء، تقول شاخصة أن “فيلق العمال المصريين” و”فيلق النقل بالجمال” قد “دفنت بالقرب من هذا المكان”.
مباشرة إلى الجنوب، خارج جدران المقبرة، يحتجب مخيم شاتيلا الحالي للاجئين خلف الأشجار الكبيرة والمشهد المزدحم بالتفاصيل.
إذا كانت الشرارة التي أشعلت كارثة الشرق الأوسط الحالية أشعلها غزو الولايات المتحدة للعراق في العام 2003، فإن المتفجرات كانت قد أُعدت جيداً قبل 100 عام سابقاً. في هذه الأيام، يعرف الجميع عن حدود سايكس-بيكو. وكما يقول المثل الشائع: “الحرب هي طريقة الله لتعليم الأميركيين الجغرافيا”. وفي الحقيقة، ضمت كل الكيانات الكولنيالية الجديدة في الشرق الأوسط خليطاً من المجتمعات العرقية والدينية. لكن هناك القليل من الحقيقة في وجهة النظر القائلة بأن ذلك قاد حتماً إلى الصراعات المجتمعية والطائفية البينية الحاضرة في شرق أوسط اليوم. إن كل الحدود المعاصرة هي ابتكارات اصطناعية بطريقة أو بأخرى، سواء حددتها نواتج الحروب، أو أقلام رصاص راسمي الخرائط الكولنياليين.
كان شيء أكثر من الجغرافيا هو الذي وضع الأسس للاضطرابات الحالية في الشرق الأوسط. بدلاً من ذلك، كان عدم الاستقرار مندغماً في اختيارات القوى الاستعمارية في داخل تلك الحدود. كان ذلك هو تلك الطريقة التي حكم بها المستعمرون.
منذ أيام أولى الإمبراطوريات المعروفة، سعى الحكام إلى حكم أراض بعيدة “بكلفة رخيصة” من خلال عملاء محليين ومن خلال قوات “محلية”. واستخدموا القاعدة الرومانية القديمة التي أتقنتها الإمبراطورية البريطانية في الممارسة “فرق تسد”. كانت هذه هي الطريقة التي حكموا بها شبه القارة الهندية الهائلة بحفنة صغيرة نسبياً من الجنود الأوروبيين والموظفين المدنيين. وتم تكرار نفس ذلك النمط، ولو بقدر أقل من الفعالية، في المستعمرات الأوروبية عبر كامل أنحاء الكوكب.
مع نهاية الحرب العالمية الأولى، كان البريطانيون حريصين على إعادة النظر في تقسيمات اتفاقية سايكس-بيكو السرية للعام 1916، التي حلت محل ولايات الشرق الأوسط العثمانية السابقة. وأرادوا ضم الموصل –حيث أشارت المسوحات الجيولوجية إلى وجود احتياطيات نفطية كبيرة- وممارسة سيطرة حصرية على فلسطين، التي كانت تعتبر في ذلك الحين جائزة استراتيجية. ووافق الفرنسيون في مقابل نيل حصة من النفط ويد طليقة في سورية.
في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وبينما كان البريطانيون بصدد إحكام سيطرتهم على ما سيصبح العراق، تقدم الفرنسيون في العام 1920 لاحتلال دمشق من قاعدتهم الساحلية في بيروت. وفي لبنان، كانوا قد أرسوا مسبقاً أسس محمية تهيمن عليها الطائفة المسيحية المارونية، والمقسومة عن سورية، والتي تضم مناطق يسكنها مسلمون من السنة والشيعة. ولم تقبل تلك المجتمعات الانفصال عن سورية ولا بأن تحكمهم أقلية وكيلة مفروضة فرنسياً. وتمت بذلك تهيئة المسرح لأجيال من عدم الاستقرار والحرب الأهلية الكامنة أو الظاهرة في لبنان، والتي ما تزال قائمة حتى هذا اليوم.
في بقية سورية، كانت المقاومة القومية للفرنسيين متركزة بين النخبة الحضرية السنية. وجرب الحكام الجدد العديد من المخططات لتقسيم سورية إلى محافظات على أسس عرقية، ثم أداروا البلد مباشرة من خلال إدارات عملت كدمى بيد الاستعمار، والتي يشغلها الموظفون والمسؤولون الموالون أو الذين اشتريت ولاءاتهم تحت الإشراف الفرنسي. كما جند الفرنسيون أيضاً قوة عسكرية إقليمية، والتي استبعدت منها أغلبية السكان من السنة في المناطق الحضرية. وشكل العليون الريفيون والأقليات الأخرى جوهر قوات الجيش والشرطة المتعاونة، مع ما خلفه ذلك من الاستياء المتوقع لدى الكثيرين من الأغلبية السنية. وقد استمرت هذه الدينامية بعد استقلال سورية، وهي تشكل جزءاً من خلفية الحرب الأهلية الراهنة هناك.
في العراق، سحق البريطانيون ثورة كانت تتركز بين السكان الشيعة إلى حد كبير في منطقة الفرات الأوسط والمدن الشيعية المقدسة في النجف وكربلاء. ثم جندوا حليفهم، فيصل، ليحكم كملك للعراق، إلى جانب حاشيته من ضباط الجيش العثماني السني السابق. وأسس ذلك نظاماً لهيمنة الأقلية العربية السنية على السكان من الأغلبية الشيعية (والأكراد) في العراق، وهو ما سيتوج، بعد الاستقلال، بدكتاتورية صدام حسين والحرب الطائفية التي أعقبت الإطاحة به.
وأخيراً، استخدم البريطانيون دعمهم للمشروع الصهيوني كوسيلة لنيل الانتداب على فلسطين من عصبة الأمم. وعلى الرغم من أنه كان هناك تعاطف أصيل مع القضية الصهيونية بين أقسام من الطبقة البريطانية الحاكمة –إما على أسس دينية مسيحية، أو من منطلق الرغبة في ترك اليهود يستوطنون “هناك” بدلاً من “هنا”- فإن أهدافاً إمبريالية أخرى، أكثر عملية، كانت تُناقش في الأحاديث الخاصة خلال الفترة التي سبقت وعد بلفور في تشرين الثاني (نوفمبر) 1917.
كان يُنظر إلى فلسطين باعتبارها الدفاع الخارجي عن مصر البريطانية وقناة السويس –فضلاً عن كونها محطة على ساحل المتوسط لسكة حديد وخط أنابيب نفطي من بلاد ما بين النهرين البريطانية المكتسبة حديثاً. كما جادل الوزراء الإمبراطورية أيضاً (عن سذاجة، كما تبين) بأن “بيتاً يهودياً” في فلسطين سوف يصبح في نهاية المطاف جيباً أوروبياً في بلاد الشام، يمكن الاعتماد عليه ويكون موالياً للتاج البريطاني. (في العام 1918، كان اليهود يشكلون أقل من 10 % من سكان فلسطين). ووعد وجود حكم صهيوني محلي بأن يكون استعماراً بالوكالة، فعالاً من حيث الكلفة -وهي نبوءة انقلبت بطريقة سيئة على البريطانيين وبطريقة كارثية على الفلسطينيين. ففي نهاية المطاف، كانت الولايات المتحدة، بدلاً من الإمبراطورية البريطانية، هي التي جنت الميزة الاستراتيجية، خلال حقبة الحرب الباردة على الأقل.
في ضوء هذا التاريخ، من الصعب القول إن الصراع الطائفي في الشرق الأوسط نشأ من أسباب محلية بحتة. لم يكن العنف الطائفي البَيني غائباً تماماً عن المنطقة قبل قدوم الاستعمار الغربي، لكن نمطاً سائداً وعاماً من التسامح والاستقلال الطائفي كان سائداً حتى أخل به المشروع الكولنيالي، الذي لعبت فيه القوى الأوروبية الاستعمارية على الاختلافات العرقية لخدمة أهدافها الإمبريالية. وكان النفط مركزياً في ذلك الوقت بطبيعة الحال، كما هو حاله اليوم.
ما يزال التدخل الإمبريالي في الشرق الأوسط متواصلاً حتى هذا اليوم، بما ينطوي عليه ذلك من النتائج الكارثية المتوقعة على شعوب الشرق الأوسط. لكن تحالف القوى الاستعمارية السابقة مع الوكلاء المحليين أصبح يتحلل الآن ويغير وجهته. فبينما كان البريطانيون ذات مرة قد عززوا الهيمنة السنية في العراق، تدعم الولايات المتحدة الآن حكم الشيعة (والأكراد)؛ وبينما وظف الفرنسيون الأقليات العرقية/ الدينية للسيطرة على سورية، تدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون النزعة الانتقامية السنية. والشيء الوحيد الذي بقي على حاله من دون تغيير، هو تواصل الاعتماد على السيطرة الصهيونية على فلسطين.
كانت النتيجة هي إطالة أمد الدمار الإقليمي الذي بدأ بالحرب والاستعمار قبل مائة عام. والآن، أصبحت سورية ممزقة وربما تحطمت بشكل دائم ككيان موحد؛ والعراق يناضل للتغلب على عقود من الغزو الأجنبي واستمرار الصراع الداخلي؛ ولبنان يوجد بالكاد كدولة عاملة؛ ومعظم الفلسطينيين بلا دولة، تحت الحكم الصهيوني أو في المنفى.
كما علق مؤرخ روماني شهير على جشع بناة الإمبريالية في أيامه: “إنهم يقيمون قفاراً ويسمون ذلك سلاماً”.
جيف كلين – (كاونتربنتش)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
.
*نشر هذا الموضوع تحت عنوان:
The Colonial Roots of Middle East Conflict
ala.zeineh@alghad.jo