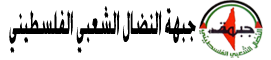أربعون عاماً مرت على اندلاع الحرب الأهلية. يؤكد اللبنانيون دائماً أن هذه الحرب لا تزال قائمة إلا أنهم يصرون أيضاً على إحياء «ذكرى» شرارة الحرب المستمرة. عام 1990 وُقّع اتفاق الطائف، عفى الزعماء عن بعضهم البعض وتسلّم مجرمو الحرب الدولة مجدداً. أحلام اعادة بناء دولة تحطمت سريعاً جداً؛ بعد ربع قرن على انتهاء الحرب تبيّن أن «الجرائم» التي حصلت بعدها كانت استكمالاً وترسيخاً لما جرى أثناءها.
قُتلت المدينة وسُلب تاريخها وذاكرتها وتكرست خطوط التماس، تراكم الدين العام ليصل الى 70 مليار دولار، ازدادت موجات الهجرة بشكل كثيف، اتُّبعت سياسات اقتصادية مدمرة، ازداد التفاوت الاجتماعي وانتشر الفقر والحرمان وبدأ النمو السكاني بالانحدار سريعاً. أحسن أرباب السلطة في لجم قيام أي دولة. سيطروا على الناس وخنقوا الاقتصاد. بدأت القصة بكاملها مع ما سُمّي «إعادة الإعمار». عوض الإعمار دخل البلد في عملية تدمير ممنهج لكل شيء. كان المطلوب أولاً قتل روح المدينة، تهجير سكانها وتمزيق المناطق بما يكرّس خطوط التماس العسكري.
«سوليدير»: تدمير التاريخ
بعد الحرب تركّز همّ ارباب السلطة على 3 أمور رئيسية هي: تدمير تاريخ وسط بيروت، إعدام الحيز العام وهدم الأسواق التقليدية.
يبدأ المعمار رهيف فياض كلامه بتأكيد أمر أساسي: «سوليدير هي أصل المشكلة في كل ما شهدناه بعد الحرب. حتى التفتيت المذهبي الحاصل اليوم سببه سوليدير لأنها دمرت النسيج الاجتماعي وفصلت الناس عن بعضهم».
إنّ تمزّق المدينة يرتبط بمسألة واحدة هي «إعمار» وسط بيروت الذي أصبح وسط بيروت «التجاري» عن عمد. يشرح فياض أنّ «سوليدير أهملت القيمة التاريخية لوسط بيروت واستبدلتها بالقيمة التجارية لأسباب واضحة نعيش نتائجها اليوم». تمتد بيروت القديمة من ساحة البرج شرقاً الى باب ادريس غرباً، ومن البحر شمالاً الى ساحة رياض الصلح جنوباً. «ابتلعت سوليدير بيروت، ولم تتملك الأرض فقط بل تملكت تاريخ المدينة وغيّرته»، يقول فياض.
ما أقدمت عليه الشركة بعد الحرب يلخصه فياض بمسألتين مهمتين هما: أولاً قطع علاقة المدينة بالبحر وهو الميزة الأساسية لبيروت. «عبر الردم أصبح البحر بعيداً فقطعت العلاقة الحسية بين الناس والبحر. هذه العلاقة لم تُقطع يوماً خلال الحرب لكن بعد الحرب أغلقوا البحر أمام الناس». حتى خليج السان جورج تمّ تحويله الى مارينا خاصة.
المسألة الثانية هي إلغاء الحيز العام، أي الأرصفة والساحات وأماكن التجمع. يقول فياض: «كانت هناك ساحة البرج، ماذا فعلوا؟ أزالوها عبر توسيعها وجعلها مفتوحة بشكلٍ يقسم المدينة الى شطرين ما يعزز انقسام الناس». أما ساحة دباس انتهت، أصبحت اليوم تسمى «الصيفي». لم يعد هناك مكان في «قلب» البلد لالتقاء الناس، طردت الشركة الناس من وسط بيروت وأحضرت غيرهم من الأغنياء. يشرح فياض أن «الساحة كانت مكاناً شعبياً لكنهم غيروا طبيعة الشوارع ومستعمليها. رفعت الشركة أسعار الإيجار وأصبحت الشوارع للاغنياء، أما الناس فيزورون المنطقة عبوراً فقط كأنهم يذهبون الى مدينة اخرى لأنها باتت خارج المناخ المديني لبيروت». بعد الحرب، مات نبض الحياة في قلب بيروت بعدما كان يضج بالتجار والمسافرين والمتنزهين وتحولت الى جزيرة معزولة فارغة يشعر الناس انهم لا ينتمون اليها.
لم تقتصر مرحلة «الإعمار» على إلغاء الحيز العام وقطع العلاقة بالبحر بل دمّرت الأسواق التقليدية وأوجدت أسلوب تسوق حديث هو المجمعات التجارية. يؤكد فياض انّ «عملية هدم الأسواق التقليدية لم تكن مرتبطة بالحرب بل بمرحلة ما بعد الحرب وكانت عملية ارادية ومقصودة لتغيير طابع الأسواق وهذا جزء من عملية تغيير روح المدينة». يقول: «دمروا الأسواق كي يمنعوا الفئات الشعبية من العودة. كان هناك حل بترميم الأسواق لكنهم اختاروا تدميرها». هكذا بعد الحرب، أزيل المعلم الأساسي الذي يميّز المدن وهو الأسواق، لأنها تدل على الهوية، الثقافية، الذاكرة الجماعية واستمرارية توارث العادات. حافظت سوليدير على الأسماء مجبرة لكنها قتلت الروح.
هلّل الناس للأموال التي تدفقت من أجل «إعمار» بيروت ليستفيقوا لاحقاً على دينٍ هائل!
الجميع في خدمة الدين العام
بعد الحرب، استُغِلّت حجة «إعادة الإعمار» في النواحي كافة. الأسباب الحقيقية للدين العام مختلفة واكتشفها اللبنانيون لاحقاً.
يتحدث وزير العمل السابق شربل نحاس عن الأسباب الحقيقة للدين العام، «حتى عام 1996 كانت هناك حاجة سياسية لتأمين شرطين هما: أولاً، أن يكسب زعماء الحرب الذين دخلوا ضمن التركيبة السياسية عام 1992 مشروعية تجاه الناس فصُرفت مبالغ كبيرة لتأمين هذه المشروعية عبر صناديق وتوظيفات وتنفيعات.
ثانياً، إعطاء المجموعة الثانية من مكوّنات السلطة الجديدة، أي جماعة الأموال، مواقع قيادية والهيمنة على البنية الاقتصادية السابقة». يقول نحاس: «دفع هذا الأمر الى خيارات اقتصادية سيئة من بينها تخفيض الضرائب على الأرباح والأموال وتأمين منافع كبيرة لقطاعي العقارات والمصارف، ما ترتب عنه إنفاق كبير وتقلّص في الإيرادات». ويضيف أنه «جراء هذين التوجهين أصبح هناك توسع هائل في الإنفاق نتج منه تراكم سريع جداً للعجوزات والدين وسميت هذه المرحلة بـ»الرشوة».
عندما تبيّن ان الرشوة على عكس المتوقع لن تُمحى آثارها، دخلنا المرحلة الثانية التي ما زلنا فيها حتى اليوم وهي «مرحلة التهديد».
مرحلة التهديد، وفق نحاس، تعني منع المطالبة بأية خدمات عامة أو تصحيح للاجور او إعادة توزيع للثروة، لأن هذه المطالب تمثّل عنصراً مهدداً لاستقرار الليرة وعمل المؤسسات العامة، وبالتالي جرى اتباع مجموعة قرارات منها تجميد الاستثمارات حتّى في الصيانة، تجميد الأجور في القطاعين العام والخاص…
حجم الدين العام اليوم يبلغ تقريباً 70 مليار دولار، وكل لبناني يولد عليه 20 ألف دولار ديناً بحجة «الإعمار»، لأن أرباب الدولة اتبعوا عمداً سياسات اقتصادية مدمّرة.
بناء اقتصاد «وهمي»
بعد الحرب كانت هناك فرصة أن يتبنى لبنان سياسات اقتصادية وصناعية بهدف بناء اقتصاد صناعي ديناميكي.
يؤكد رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية غسان ديبة أنه كانت هناك فرصة «بالاعتماد على إرث الصناعة اللبنانية التي ازدهرت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وعلى الكم الهائل من المتعلمين اللبنانيين. كذلك الاستفادة من النمو وتدفق الرأسمال الذي دائماً يحدث في البلدان التي تخرج لتوها من الحروب المدمرة، محققاً بذلك حلقة حميدة من النمو الاقتصادي والاستثمار في الاقتصاد الحقيقي وخلق الوظائف وزيادة الاجور وتراكم الرأسمال البشري». يقول ديبة: «لو حصل ذلك لكان لدينا الآن اقتصاد اكثر تطوراً، تحتل القطاعات العالية الانتاجية مكانة مهمة فيه ويخلق الوظائف ذات الاجور المرتفعة ولكان توزع الدخل والثروة اكثر مساواة».
لكن ما هي الخيارات الاقتصادية التي سار بها «قادة» مرحلة إعادة الإعمار؟
«تم بناء اقتصاد ريعي يعتمد على استدانة الدولة وهجرة العمالة وتدفق رؤوس الاموال من اجل الاستثمار في سندات الخزينة وودائع المصارف والعقار، منتجاً بذلك فوائد مرتفعة وارتفاعاً في قيمة العملة اللبنانية»، يشرح ديبة.
«تراجع الاقتصاد الحقيقي وشهدت الصناعة تراجعاً في حصتها من الناتج المحلي من 12.5% عام 1997 الى 8.8% عام 2009. كذلك سيطرت القطاعات المنخفضة الإنتاجية ذات الأجور المنخفضة، وانخفضت حصة الاجور من نحو 50% من مجمل الناتج المحلي قبل الحرب الى نحو 25%». كما ازداد سوء توزيع الثروة وحصة الرأسمال الريعي نتيجة ارتفاع الفوائد وتراجع النمو الاقتصادي والانخفاض النسبي للعائد عن العمل، فبلغ مؤشر «جيني» لتوزع الثروة في لبنان 0.86 عام 2013 ما يعتبر من اعلى معدلات عدم المساواة في الثروة في العالم. بعد الحرب، ازداد التفاوت الاجتماعي!
توسع الحرمان: السياسات الفاشلة
«لا شك أن الحرب هي آلية لإعادة توزيع الثروة. صحيح أنها خفّضت مستوى الثروة العامة وضربت الناتج المحلي لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الفقر ازداد بسبب الحرب». يقول الباحث في التنمية أديب نعمة إن «الحرب لديها ميكانيزمات خاصة بتوليد الثراء، سواء كان مشروعاً ام غير مشروع، ما يؤدي الى توزيع الثروة. والتفاوت الاجتماعي بين الفقراء والاغنياء ربما يكون تقلص خلال الحرب لكنه ازداد حتماً بعد الحرب».
يشرح نعمة أنه وفق دراستين عن خريطة الأحوال المعيشية حصلتا عام 1994 و2004 تبيّن انه خلال 10 سنوات انخفض معدل الحرمان العام أي ارتفع مستوى التعليم وانخفض معدل وفيات الأطفال والأمهات… لكن عند مقارنة وضع هذه المؤشرات بالنسبة للمؤشرات المتصلة بالدخل اي الوضع الاقتصادي، تبين ان المؤشرات الاجتماعية تحسنت بينما تدهورت المؤشرات الاقتصادية أي تراجع الوضع الاقتصادي للاسر وازدادت البطالة… يقول نعمة: «خلال 25 سنة اتت المحصلة سلبية. كان هناك تحسن طفيف في فترات معينة لكنه كان تحسناً قطاعياً موقتاً وجزئياً، في حين بقي الميل العام في تدهور على المستويات كافة».
يتحدث نعمة عن نقطتين أساسيتين تراجعتا بشكل كبير بعد الحرب. على صعيد الوضع السياسي، تبيّن أن فكرة الدولة بعد الحرب اضمحلّت، «خلال الـ 25 سنة أصبحت الدولة أضعف من ما كانت عليه أثناء الحرب! وهذا الأمر له تأثيراته في الوضع الاقتصادي والاجتماعي».
أما على الصعيد الاجتماعي فقد دُمّر النسيج الاجتماعي بعد الحرب وأصبح لدينا تفكك مناطقي ومذهبي أشد من المرحلة السابقة. لكن هل اتبعت الدولة سياسة لمحاربة الفقر بعد الحرب؟ يرى نعمة أن السياسة الرسمية للدولة قامت على ان «عملية اعادة الاعمار والنمو ستجلب الرخاء الاجتماعي وهذا صحيح جزئياً، لكنه لم يحصل بطريقة شاملة ومستدامة، أي انه لم تكن هناك آليات للاستمرار فدخلنا مرحلة تباطؤ النمو الاقتصادي». لمواجهة مشكلة البطالة التي ارتفعت أخذت الدولة الخيار الأسهل: التهجير.
هاجروا واعملوا وحوّلوا
يؤكد الخبير الاقتصادي والباحث في شؤون الهجرة الدكتور بطرس لبكي أنّ الهجرة هي نتيجة لفترة ما بعد الحرب وهذا واضح بالأرقام، فأثناء الحرب كان هناك نحو 60 الف مهاجر سنوياً من لبنان. بعد الحرب، في اوائل التسعينيات، انخفض العدد قليلاً إذ عاد بعض المهاجرين الذين تأملوا خيراً بعودة السلام وبناء الدولة فسجّل عام 1991 نحو 50 الف مهاجر، وعام 1992 سجل 39 الف مهاجر مقابل 40 الف مهاجر عام 1993.
لكن بعد ذلك، يقول لبكي: «بدأ العدد يرتفع بسبب الأزمة الاقتصادية التي ظهرت جراء تثبيت سعر صرف الليرة، ارتفاع الفوائد، ارتفاع سعر الصادرات، السياسات الاقتصادية التي اتبعت والاتفاقيات التجارية مع دول إنتاجها أقل كلفة من لبنان».
جرى خنق الاقتصاد وارتفعت البطالة فسجّل عام 1996 نحو 186 الف مهاجر، 150 الف مهاجر عام 1997، 173 الف مهاجر عام 1998 و127 الف مهاجر عام 2000.
يوضح لبكي انه أثناء الحرب كانت «الفئة الشبابية (20 الى 30 سنة) تميل أكثر الى الهجرة لكن بعد الحرب أصبح هناك توسّع بحيث انضم الكبار والأطفال الى موجة الهجرة بسبب ازدياد البطالة». ويلفت إلى أن «المستوى التعليمي للمهاجرين أعلى من المستوى التعليمي للمقيمين بحيث شكل الجامعيون 16% من المقيمين و20% من المهاجرين». بعد انتهاء الحرب أصبح السبب الاقتصادي الدافع الأساسي للهجرة.
يشير لبكي الى أن الدولة تشجع الهجرة لسببين أساسيين، «أولاً هناك سبب سياسي إذ تشكل الهجرة صمام أمان من أجل الحفاظ على استقرار النظام، فالعاطلون عن العمل، وتحديداً الشباب، من الممكن أن يمثلوا عنصر ازعاج للسلطة في حال بقيوا في البلد».
أما السبب الثاني فهو اقتصادي، فمع ضرب الانتاج أصبحت الهجرة تؤمن عائدات عبر التحويلات الخارجية لكنها بقيت أقل مما يمكن أن يزيد على الدخل في ما لو بقي المهاجرين في لبنان وأنتجوا. ما يحصل هو عملية استثمار في تعليم الفرد تكلّف الدولة والأسرة نحو 200 الف دولار لكن عندما يبدأ الفرد بالإنتاج نرسله الى الخارج فلا يعطي أي مردود إلى الداخل.
يلفت لبكي الى ان الهجرة «الغت الدورة الاقتصادية التي يمكن أن تحصل في حال عمل هؤلاء في لبنان (من إنتاج، إيجار، إستهلاك في الداخل، شراء مواد أولية…) ما يعني أن الدولة فضلت استبدال آلاف الدولارات الناتجة من كل دورة اقتصادية بـ500$ يحولها المهاجر شهرياً».
يضيف: «التحويلات الخارجية مجرد وهم، يتحدثون عن 7 مليار دولار سنوياً لكن أكثر من نصف هذه المبالغ يذهب كأجور للعمال الأجانب».
للهجرة أيضاً آثار معنوية بحيث انخفض عدد الزيجات ما أدى الى انخفاض النمو الديغرافي وتحولت البنية السكانية إلى بنية هرمة، أي أقل إنتاجية وابداع.
الخطر الديمغرافي: تثبيت الفرز
يرى عميد كلية السياحة السابق في الجامعة اللبنانية الدكتور علي فاعور أن الهجرة أثرت كثيراً في النمو السكاني إذ أخذت طابعاً شبابياً- ذكورياً ما أدى إلى نقص الولادات وانخفاض معدل الخصوبة. عام 2000 كان معدل الولادات يبلغ 60 الف ولادة سنوياً أما اليوم نتحدث عن 32 الف ولادة سنوياً فقط، ما يعني ان معدل الهجرة مرتفع أكثر من النمو السكاني.
يقول فاعور إن «بعد الحرب لم يتم وضع أي خطة استراتيجية لإنماء القرى وتخفيف الضغط عن المدن، بالعكس أصبح لدينا اختلال بارز في التوزيعات المكانية للسكان إذ ضمّت المنطقة الساحلية، التي تبلغ مساحتها أقل من 10%، نحو ثلثي سكان لبنان بسبب تركز الخدمات في المدن». ويضيف: «أحدثت الحرب انكسارات في البنية السكانية أسميناها خطوط تماس بين المناطق، لكن بعد الحرب توسّعت هذه الانكسارات وجرى تثبيت الفرز الطائفي».
سياسة التعويضات التي اتبعتها الدولة لم تنجح، وفق فاعور، في إعادة المهجرين الذين شكلوا ثلث سكان لبنان آنذاك، إلى مناطقهم. يقول فاعور إن التعويضات بعد الحرب كانت انتقائية ذات غايات سياسية ومناطقية، وفي ظل غياب الإنماء ازدادت رغبة المهجرين في الداخل إلى الهجرة الى الخارج.