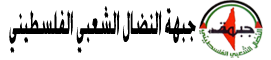بالنظر إلى التحديث الكبير، الذي طال العلاقات المتبادلة بين الأنظمة العالمية، فإن ظاهرة التحلي – ولو شكليا- بما تيسر من السلوك الحضاري، أصبح مطلبا أساسيا، حتى في أشد حالات الصراع السياسي والاقتصادي، الذي تطفو آثاره بشكل دائم على سطح هذه العلاقات، مع التأكيد المستمر على حسن النوايا تجاه الآخر، المجسد طبعا في دولة أو شعب، خاصة تفادي التصريح باحتمال التعرض من قِبله لعدوان منظم ورسمي، لأن هذا النوع من العدوان ينتمي إلى مرحلة متقادمة، من مراحل الصدامات والتوترات العسكرية، التي تحتفظ بها الذاكرة التاريخية، وتبعا لذلك أمسى مطلب التحديث يشمل كل شيء، بما في ذلك برمجة التطبيقات ذات البعد الدبلوماسي، التي تُشَنُّ بموجبها أشد الحروب ضراوة، ذلك أن فتح جبهة مباشرة ضد جهة معينة، ليس في الواقع سوى إعلانٍ صريحٍ، عن إِيقادِ فتيل حربٍ مبيتة ضد الحداثة، التي طورت على امتداد العقود الأخيرة آلياتها الأنيقة، الموظفة، في قمع وامتهان الشعوب الضعيفة أو الممانعة.
واقتداء بهذا السلوك الحضاري، أمسى الجميع مطالبا بانتهاج سياسة غض الطرف، وتحاشي التعريض بأي دولة ذات سيادةٍ، يُفترض فيها أن تكون مصدر تصعيدٍ سياسي، وطرفا مباشرا في الرفع من غليان تِنَّوْرِ الحرب، حيث يُقتَصَرُ على وضعها ضمن خانة رعاة الإرهاب، كحد أقصى لاتهامها بتحللها التام أو الجزئي من مسؤولية الالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية. ومنهجية غض الطرف هاته، هي التي تتيح للإرهاب الفعلي إمكانية احتفاظه بغموضه ومجهوليته، وهي الوضعية التي يتحقق على ضوئها الرفع من سقف التوجس الكوني، والتعبئة المستدامة، ضد قاتلٍ مُتَخيَّلٍ وملتبس أمسى خلسة مقيما بين ظلالنا.
هذه الحرب الجديدة، يتم تصريفها بشكل ملموس في الألعاب الافتراضية، التي تضج بها برامج تشغيل محركات الشبكة العنكبوتية، حيث الجميع مدعوون للمساهمة بقسط ملموس، في خوض غمار الحرب الغامضة والشاملة، بمختلف فئاتهم العمرية، لا فرق في ذلك بين الأطفال، الشبابِ أو الشيوخ، فالجميع مَعْنيون بالاندماج في مشروع حروب افتراضية، من أجل التأقلم مع الاحتمالات المباغتة، والكفيل بإحباط ما يخطط له الآخر من هجمات، وبفعل استناد مروجي هذه التمارين العسكرية إلى الجانب السيكولوجي، في استقطابهم للمزيد من المتطوعين، والمزيد من الرصاصات الطائشة، فإنهم يقومون بإعداد تطبيقات عدوانية، تستجيب لنزوات القتل لدى كل الأجيال، حيث تتأتى للعموم، إمكانية معايشة الحرب والتمرن على ويلاتها وجحيمها، بوصفها حدثا حقيقيا، وليس مجرد استيهامات، وحالما يشعر اللاعب/ المقاتل باستنفاده لأهوال اللعبة/ المعركة، فإن قدراته السيكولوجية، التكتيكية، والفيزيولوجية أيضا، تلجأ إلى تجديد طافتها، بالبحث عن معارك أكثر تعقيدا، وأكثر شراسة ودموية، أو بتعبير آخر، أكثر واقعية.
والملاحظ أن المختبرات التي تتحكم في إنتاج طقوس القتل، تحتاج دائما إلى مرجعيات ذات عمق مادي وملموس، في صيغة تفجيرات منتظمة، تحدث هنا وهناك، وتكون عادة معزولة ومشحونة بعنفها المأساوي، بفعل ما تخلفه من خسائر في الممتلكات والأرواح، خاصة حينما تكون مسارح الجريمة مزودة بذاكرتها التراثية والثقافية، وكافية لتأطير كل الخطابات المحايثة، التي من شانها تعميق الوعي باحتمال تجدد حدوث هجوم محتمل، بين لحظة وأخرى، بمعنى أن التحسيس بقرب حدوث الهجوم، يتحقق عبر توظيف جميع الإمكانيات التقنية والفنية، خاصة منها الأشرطة السينمائية ذات الطابع الهوليوودي، التي يتم فيها اختلاق كائنات عدوانية شريرة ومخيفة، منتمية إلى كواكب مجهولة، أو تلك المخلوقات المُجَرْثمة التي تتوالد، وتتكاثر عن طريق الخطأ العلمي بفعل تفاعلات كيماوية، غير طبيعية، أو بفعل بحوث وتجارب مقصودة في ذاتها، وكلها تحيل ضمنيا إلى الآخر الذي ينبغي المبادرة بإفنائه. من هذا المنطلق، ينبغي التأكيد على ظاهرة الجيش اللامرئي، التي أصبحت الموضوع الأثير للأنظمة التقليدية والحداثية على السواء، فلكل شعب أعداؤه الافتراضيون، الذين يكونون عادة مؤطرين بنواياهم العدوانية، بدون أن تتوافر شروط تحديد هويتهم بشكل واضح ومباشر، الشيء الذي يستدعي القيام بمبادرات استباقية، من شأنها وضع معايير ثابتة ومعلومة للهويات المعنية بالمطاردة، من أجل اعتمادها كنماذج صالحة، لتقديم تصور عام وشامل، للجيش العرمرم المندس خلسة بين الجِلْد والعظم، الذي يمكن في أي لحظة أن يداهمك، فور انفلاته من سريته.
وبما أن الموضوع يحظى باهتمام العالم أجمع، ضمن إطار تعميم حالة الإيهام بقرب تطاير شظايا الكارثة، فإن التواصل الكوني، يكون قد تمكن من إيجاد حلول عملية وحاسمة، لإشكالية التفاهم التي لن تتحقق ولو جزئيا، إلا بمنطق الإجماع على أن فوبيا الآخر، قد اكتسحت الماء والهواء، مصحوبة بكل ضمانات انعدام الأمان، فما يُوحِّد بين الأمم حاليا، ليس المشاريع الاقتصادية، أو العلمية والاجتماعية والثقافية، بل الخوف الشديد من ذلك الشيطان المتخفي الذي استطاع بفعل القدرات الإعلامية والتحليلية والتنظيرية، أن يتحول إلى فكرةٍ، لها شكلُ شبحٍ، وشكلُ حالةٍ سديمية، يتعذر تطويقها ومحاصرتها. إنها الأرضية النظرية المؤهلة نسبيا لخلق أجواء التعاطف المشترك، الذي عجزت عن تحقيقه قضايا أساسية من قبيل ضحايا الحروب، المجاعات، وقوارب الموت، وضحايا التهجير القسري، فضلا عن ضحايا الأوبئة والكوارث البيئية بكل أنواعها، فكل هذه القضايا الجوهرية واللصيقة بمصير الكائن، وبحقه في الحياة الكريمة، أمست لا تحتل سوى حيز جد متواضع في حقل الاهتمامات الدولية، كما أنها أمست موضوعا ذا طبيعة مهرجانية واحتفالية، لا تلبث أن تنزوي في هوامشها المنسية، مباشرة مع انطفاء الأضواء، وعودة المحتفلين إلى ملاذاتهم، كي يجددوا آليات تحصينهم من مخاطر ذلك المجهول، الذي استطاع بجاذبيته السحرية أن يحتل مكانته المتقدمة في الحياة العامة والخاصة، حيث إمكانية فك شيفرة القاتل اللامرئي، هي الوسيلة الأنجع لتعميق وتوثيق أواصر أي قرابة محتملة بينك وبين الآخر. كما أن الإحاطة بالمعلومة المتعلقة بالغامض المدمر، هي اللغة الوحيدة التي تمتلك سلطتها الإجرائية الكفيلة بالارتقاء بالحوار إلى إطاره العقلاني والحضاري، وبالتالي، فإن جميع ما يمكن أن يحدث من كوارث صغيرة أو كبيرة، يتم إسنادها للمجهول، لأن إلصاقها به، حتما سينزه المعنيين عن كل ما يقعون فيه من أخطاء، وعن كل ما يمكن أن يوجه إليهم من إدانات، كي يكونوا في حِلٍّ من أسبابها، ومن تداعياتها، وخارج أي متابعة أخلاقـــية، أو قانونية، وفوق كل شبهة.
إن المجهول الذي قد يحمل اسمك، هو المشجب الأكثر إثارة لتعليق كل ما يتعقب دولة ما من فشل وإحباطات وانزلاقات اجتماعية واقتصادية، وتعليق كل ما يمكن أن يشوب مساراتها من انحرافات.
إن الخطر المتوقع من المجهول، أمسى ضرورة تاريخية وحتمية، ومبدأ استراتيجيا بالنسبة للجميع، حيث سوف نظل بحاجة ماسة إليه، في انتظار اكتشاف شكل آخر من أشكاله، فلا يمكن تخيل استمرارية نظام ما، بدون مشاجب، وبدون قمصان عثمانية النسيج. إنها شكل من أشكال المقاومة التي تسهر الحداثة على تدبيرها، من أجل التصدي لمحتمل، ليس له أن يكون بالضرورة واضحا ومعلوما.
٭ شاعر وكاتب من المغرب
القدس العربي