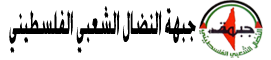إسم الفيلم: 18 يوم – مصري
إخراج: شريف عرفة،مروان حامد،يسري نصرالله.
إن حدثاً هائلاً أدّى تغيير واجهة الحياة في بلدٍ محوريٍ كبير مثل مصر ، و ما زال سبباً في التغييرات التي تشهدها المحروسة ، وعلى غير صعيد ، يتطلّب من أيِّ عملٍ فنيٍّ أن يتروّى قليلاً قبل أن يتناول ذلك الحدث . بمعنى أن ينتظر حتى تتخمّر الأحداث ويتبيّن المصير أو الدرب الذي ستسلكه خطوات هذا البلد .
لكنّ هذا الفيلم قد تعجّل الظهور ! فتنادى صُنّاعهُ وقدّموا لنا عملاً أراه ينتمي إلى ما أسمّيه ” الإبداع الميداني ” ، وهو إبداعٌ يتخلّق في اللحظة المشتعلة وفي ساعة وقوعها . وأعتقد أن الأفلام والروايات والدراسات والأبحاث ، تحتاج إلى مسافة زمنية بعد وقوع الحدث ، لتتأمّله وتهضمه وتتمثّله ، ثمّ تقدّم إبداعها عنه ، بهدوءٍ أكثر وبرويّة وتبصّر كبير عميق . لهذا ربّما انزلق الفيلم إلى التكرار والاجترار والعاديّة والميكانيكية والمبذول والسائد والمعروف ، ولم يتمكّن من الغوص في أحشاء ما حدث والتمعّن بوعيٍ في قيعان ذلك المحيط الذي تلاطم وقذف بطوفانه في ثورة هي عتبة كبيرة ، أفضت إلى بوّابات أخرى .. لتعبر مصر إلى أرضها الرّاسخة ، ولتواصل إشاعة الأمان ، وتتجاوب مع نداءات ميدان التحرير وشعاراته المحقّة ، في يناير ثم في يونيو ويوليو لاحقاً.
وبسبب التعجّل ، أعتقد أيضأ أن الفيلم كان متقشّفا من الناحية الفكرية ، واستمرأ الموجود والمتوفّر الهامشيّ والمروريّ ، ولم يتمكّن من اكتساب واختزان وهج الثورة ، وذاك الحراك المدوّي في ميدان التحرير ، وتداعياته التي رجّت البلاد والإقليم ، وإعادة ضوء الدم والصراخ وصدام الأكتاف إلى المُتلقّي .
وإذا اتفقنا على أنّ أيّ ثورة تنهض على أعمدة ثقافية واجتماعية واقتصادية ونفسية .. متداخلة ومركّبة ، أو ترتكز على نظرية عوامل متعددة ، ويوازيها جدل وحوار سياسي وفكري ووطني .. محتدم وعميق وواسع ومعقّد ومتواصل .. فهل تراءى لنا ذالك في هذا الفيلم ، ولو بالحدّ الأدنى المطلوب ، مع إدراكنا بأنه فيلم وليس خطاباً سياسياً محضاً ؟!
***
هذا الفيلم افتقد للحكاية ، وحاول أن يجترّ صوراً ومشاهد نمطيّة ومتوقّعة .. بل ومُعادة فكرةً ولغةً وأداءً.
وربما كان كان ينبغي على الفيلم أن يدرك بأن إبراز معانيات الشعب ، أو إيصال فكرةٍ ما ، يحتاج إلى عمق فكريّ ، وإلى حفرٍ حصيف في دواخل المكوّنات الاجتماعية والنفسية والثقافية .. إلخ ، مثلما يحتاج إلى شكل فنيّ فيه من الجِدّة ما يجعله أكثر إقناعا ، ويحقّق التشويق ، بالمعنى الواسع ، باعتبار ذلك هدفاً رئيساً لأيّ منتَجٍ فنيّ ، بالضرورة .
كما أنّ الحوار الساذج التقليدي المتخلّف العصبيّ الذي أجراه المحقق ” إياد نصّار” مع المُتّهم عصام ” عمر واكد” يدلل على أن أداء المُمثل المُحقّق التعيس كان في منتهى التسطّح والسذاجة والقُبح ، ويعكس صورة بائدة لم تعد قائمة في أعتى زنازين الدول التي تعيش في العصور الوسطى والمظلمة.
و لعل أداء عمر واكد قد أنقذ المشهد المُبتذل ! لكن تمثيل ذاك الممثل العجائبي البدائيّ المكرور والفائض عن الحاجة .. بل والمضحك ، قد هبط بالفيلم إلى دركٍ سخيف ، لا يليق بتاريخ باقي المُمثلين ، مثل باسم سمرا وعمر واكد.
وقد يكون خيط السخرية أو الفكاهة – وثمّة فرق بينهما – الذي حاول الفيلم أن يجعله جاذباً .. نراه قد تقطّع ، ولم يستطع أن يحمل هدف المتعة المراد منه . عداك عن أنّ التسلسل الدرامي أيضا كان متنافراً ولم يحقّق التواصل المطلوب .. ليصل المعنى . كما أن الفيلم صوَّر الجنودَ والشبانَ والناسَ بكيفيّة لا تليق بمصر وأهلها .
وأكاد أصاب بالصدمة لأنّ مخرجي الفيلم هم أصحاب القامة والقيمة .
واللوم يقع على عاتق المخرج الذي اختار ممثلا هابط المستوى مثل إياد .. إضافة إلى أنّ المخرج قَبِلَ بمثل هذا الكاريكاتور في أداء شخصية المحقّق وبتشخيصه الرديء ، خصوصا أننا رأينا مع مطلع الفيلم أداءً عالياً من الممثلين الذين رأيناهم ” مجانين ” في مستشفى الأمراض العقلية .
و لعل ما أثار استيائي أيضا ، أن مُمثلاً لطيفاً مثل أحمد حلمي قد قدّم أداء مرتبكاً لشخصية مهزوزة جبانة مرعوبة من ” إسرائيل ” ومن ” الأمن ” و هي شخصية جاهلة ، تردّد مقولات سياسية جاهزة ومبذولة للنقاش السياسي والجدل الساخن ، دون أن تدرك فحوى هذه المقولات.
إن تضييع حوار ” أهبل” مع آلة تسجيل لهذه الشخصية ، يشير إلى فقر في أدوات المخرج الذي لم يجد وسيلة أكثر إقناعاً ونفاذاً لإيصال المضمون ، مع العلم أنه مخرج متمكّن ولا تعوزه معرفة ذلك !
وإن إبراز حالة التردّد الطفولي وترداد الجُمل ، التي تتدحرج في الشارع المصري أيام الثورة ، قد جعل الفيلم يستعيد ” حالة ” رأتها الناس وعرفتها وشبعت منها.
وإنّ تقديم ” مقاطع ” مُنبَتّة عن بعضها البعض ، لا يربطها سوى أنها حصلت أيام الثورة .. لا يجعل من هذه المقاطع عملاً يحقّق ” التغريب ” بالمعنى الذي دعا إليه برتولد بريخت ، بحيث يتم حشد كل المواطنين بالغضب ، وحقْنهم بما يدفعهم للإنفجار ، لأن هذا الفيلم يحكي عمّا جرى ببساطة تصل الى حدّ السذاجة .
ولعل ما أنقذ الفيلم قليلاً ذاك المشهد الذي حضرت فيه هند صبري وآسر ياسين .. مع وقوعهما في حوارٍ مكرور ومتوقّع أيضاً .
يا سيدي المخرج !
إنّ هذا الكمّ المحترف من الممثلين المتألقين قد تمّ تبديده في سياقٍ مُعاد وقديم ويفتقد للدّهشة والألق .. ذاك لأن إمعان النظر فيما حدث يعني أن نقلب الأرض ونحرثها ونكشف عمّا لا يعرفه ولم يقله الناس ، بل ونضيء لهم ما كان مسكوتاً عنه ، ونكشف عن الأسباب الجوّانية غير المُدْرَكة التي أدّت الى تلك الأحداث .
إضافة على ذلك ، فإن هذا الفيلم قد حاول أن يلتصق بالحياة الشعبية ويعكسها تماماً .. لكنه وقع في المحظور؛ إذ أبرز الكلمات الشعبية والمصطلحات الشوارعيّة الرخيصة والممجوجة كثيراً.. حتى وصل إلى درجة الإسفاف والجلافة .
ومع أنني ضد ” تنقية ” التاريخ و” تجميل ” البشاعة .. لكن ثمة طرائق فنيّة أكثر نضوجاً تستطيع أن تقدّم تلك الحمولة بأناقة وخفّة دم وواقعية ..أكثر.
كما أن ” الإيحاء ” افتقد للجدية والحساسية ، فكان بارداً وبليداً.
حتى أن التعبير عن القلق والعصبية ، كما رأينا في مشاهد أحمد الفيشاوي ،قد تمّ تصويرها بالإستعانة باللغة الجسدية القديمة ذاتها! عداك عن أن إيقاع الفيلم بطيء وثقيل .. أحياناً عديدة.
وإن ” السلبيّة ” التي طبعت معظم شخصيات الفيلم تعني أن الشعب كان سلبياً .. وهذا غير دقيق تماماً ، رغم إيجابية بعض الشخوص أواخر الفيلم .
وإنّ تلهّي الناس بالعبث والضحك والحكي واللعب والتفرّج والمناكفات الزوجية والتلصّص على الجيران وسماع الأغاني الهابطة والتفوّه بالكلمات الجاهزة والمعروفة سلفاً .. هبط بالفيلم إلى حدّ إثارة الشفقة على معظم هؤلاء النجوم الذين لم تتيسّر لهم عناصر فيلم حقيقي .. وخصوصاً أنه تناول مقطعاً تاريخياً صاخباً وساخناً ومتفجّراً وذا أبعاد وتجلّيات وتداعيات لا حصر لها ، وما فتئت تفعل فعلها في الحاضر المصري المعيش.
وإن تضمين الفيلم لمقاطع ” وثائقية ” تمّ تصويرها ، بالفعل ، خلال تلك الأيام ، كانت مقاطع غير معبّرة في معظمها تماماً بمعنى لم تعكس حجم وامتداد وهالات وجوهر ميدان التحرير وباقي الميادين في مصر ، خاصة وأن هذه المقاطع صاحبها ” راوي” يشرح تلك المشاهد ، بلسان الممثلة المميزة منى زكي ، التي ظهرت وصوتها ” يشرح ” ما نراه حولها ! كأننا لم نرَ التجمعات الرجراجة في الميدان ! حتى أنّ ممثلة بحجم يُسرا ظهرت وهي ” تقصّ” حكاية .. تدعو مستمعيها للبكاء ! فهل جفّت أساليب الخَلق ولم يجد المخرج آلية فنيّة تصوّر ” قصّة ” يُسرا ، لتصل بشكل أعمق وأفضل وأكثر تكثيفاً وأثراً!
كنت أتوقع أن أرى أثر تلك الأحداث العميق على الحياة الأُسريّة والعامّة في مصر ، اجتماعياً واقتصادياً وفكرياً .. كما توقّعت أن أُمسك خيطاً له استطالات وأذرع ، ويظلّ هذا الخيط ممتداً حتى يصل إلى نهاية الحكاية ، باعتبارها أن الخيط هو العمود الفقري لتلك الحكاية .
كما تأمّلتُ أن أرى فيلماً يكون معادلاً موضوعيا لزلزال يناير ، لا أن يكون صدى باهتاً مجزوءاً وأقرب إلى الإرتجال.
إنه ثرثرة حول ميدان التحرير .. ولا يعكس البتة ذلك الهدير ، الذي كان انطلاقةً تاريخية لتحوّلات ، لن تتوقّف تبِعاتها .. قريباً.
فيلم 18 يوم- ميدانيّ.. ويفتقد للحكاية وثرثرة حول ميدان التحرير الكاتب: المتوكل طه