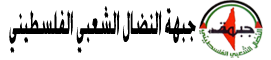منذ إطاحة حكم الإخوان المسلمين في منتصف العام المنصرم والأحداث في مصر تتوالى، كاشفة عن خطاب مختلف لهذه الجماعة دفع الشعب (وشعوباً عربية أخرى) إلى الحكم بأنها جماعة إرهابية وكشف عن وجه مختلف لها وأماط اللثام عما كان دفيناً في فكرها.
وفي الحقيقة، أظهر هذا الخطاب وما يصاحبه من ممارسات بداياته في العام الكامل الذي تربعت فيه الجماعة على سدة الحكم في مصر، لكنه اتضح بشكل مكشوف بعد إزاحتهم بإرادة شعبية، بل إن الأيام تكشف عن وجود قدر من الإصرار على أن يستمر هذا الخطاب، وأن تستمر الممارسات التي تدفعهم أكثر فأكثر بعيداً من الشعب المصري، وربما بعيداً من الشعوب العربية والإسلامية.
في هذا المقال أسئلة حول طبيعة العقل الذي يفرز هذا الخطاب ويشكل تلك الممارسات، فالخطاب وما يلحق به من ممارسات يؤشران على استمرار شكل العناد، باعتبار أن هذا العناد هو رمز للتحدي والعزيمة والتمسك بأهداف الجماعة مهما واجهت من مصاعب. وهذا الزعم ذاته يدفعنا إلى طرح السؤال حول طبيعة العقل الذي يفرز الانتحار والضياع، لا للأفراد الذين يسيرون خلفه فحسب بل لشعوب بأسرها، على ما كشف التاريخ المعاصر للشعوب التي راحت ضحية هذا العقل الجامد (أفكر في هذا السياق ببلدان كأفغانستان والصومال والعراق).
قد استعير هنا مفهوم العقل العملي لكي أتمكن من فهم هذا الظرف، باعتبار أن العقل يشكل قوة الفهم والإدراك والتمييز، فقوة الإدراك والفهم والتمييز ترتبط بقدرة العقل على التفكير والتدبر، وعلى توليد أساليب يستطيع بها البشر أن يديروا شؤون حياتهم واختياراتهم وتصرفاتهم. وثمة علاقة بين قدرة العقل على التدبر والتفكير والمرونة في مواجهة مصاعب الحياة وتحدياتها، وبين درجة الاستقرار والاستمرار والتماسك التي يحققها الشخص أو الجماعة أو التنظيم… أو حتى المجتمع بأسره. يتحول العقل هنا إلى قوة إيجابية ضابطة، فيكبح جماح الغريزة والانفعال، وينظم مسارات السلوك ويدفعها نحو تحقيق الهدف الأخلاقي الأسمى لأي سلوك، وهو الحفاظ على الصالح العام، في سعي يتسم بالمرونة والانفتاح والقدرة على إدارة الأزمات وتجاوزها.
عقل غير عملي
وهنا يظهر السؤال التالي: أي عقل عملي هو الذي يحكم خطاب وسلوك جماعة مثل الإخوان المسلمين ومن دار في فلكهم، ويدفع إلى التعصب والعنف والإرهاب في مواجهة ظروف متغيرة وتاريخ يكتب في غير صالحهم؟
وفي محاولة الإجابة، لن أميل إلى التطرف في الحكم بالقول إن الجماعة أصبحت تركن إلى عقل بدائي، فمقولة العقل البدائي لم تعد مقبولة لدى أي مفكر حديث، لكنني أميل إلى افتراض أن هناك تعانداً بين الميل إلى التعصب وبين قوة العقل العملي (والنظري أيضاً)، فالعقل المتعصب يظل يدور حول فكرة واحدة حتى يُهلِك صاحبه. يفقد هذا العقل المتعصب أي صلة بالعقل الحديث، إنه عقل متحجر يطرح المقولات ويجعل معيار صدقها مقولات أخرى، ويحاور ويناور من دون أن يسمح لأي أفكار جديدة أو مخالفة أو مغايرة أن تتسرب إلى هذه المقولات، بل إن الأفكار الجديدة والمخالفة والمغايرة غالباً ما يُنظر إليها باعتبارها ضالّة لا ترقى إلى مستوى الأفكار (الفاضلة!) التي ينتجها (أو قل يرددها) العقل المتعصب.
يصاب العقل هنا بضرب من الوهن والإرهاق الناتج من فرط الدوران حول الفكرة الواحدة، ويصعب عليه أن يتطور وأن ينفتح على الخبرات المتجددة وعلى العالم الأرحب، ويتحول في حالة الميل الشديد إلى التعصب إلى عقل أسير، فيقع فريسة لكل من يلوح له ببارقة أمل، حتى وإن كانت خداعاً، فيؤدي ذلك إلى مزيد من دوران العقل ذاته وإصراره على السير في الطرق غير الممهدة.
ومن ناحية ثانية، فإن هذا العقل المتعصب يكاد يزهق نفسه عندما يستبدل الغريزة بالمنطق العقلي، والانفعال والاندفاعية بالتدبر والرؤية. يتجلي ذلك في ميل أفراد الجماعة إلى العنف، واتخاذ الإرهاب سبيلاً لتحقيق أهدافها، من دون تفكير بأن ذلك يدفعها دفعاً إلى دائرة الظل وتسييج صورتها بسياج الكراهية والنبذ.
والحقيقة أن انتهاج العنف، أي الميل إلى الغريزة من دون العقل، يُدخل الجماعة في حلقة مفرغة من مظاهر سوء الفهم وعدم القدرة على التفكير التدبري الواعي الرشيد، من ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- عدم القدرة على فهم المتغيرات العالمية، وعدم الوعي بالمخاطر المحدقة بالوطن، وعدم تقدير حجم المسؤولية الأخلاقية عن الأفعال والممارسات، وعدم إدراك طبيعة الصالح العام ومكوناته، والفشل في قراءة التاريخ (الماضي والحاضر). وتُضاف كل هذه الممارسات إلى ممارسات عدائية سابقة، فتعمق الصورة النمطية ضد الجماعة، بأنها جماعة إرهابية عنيفة، وتجعل الأفق أمامها ينغلق من دون أمل في فتح قريب.
نحن في حاجة إلى أن نطور وعياً فكرياً وعملياً تجاه هذا العقل المتعصّب، فخطورته لا تكمن في أنه يسم تفكير جماعة ما أو تنظيم ما، لكنّ خطورته الكبرى تكمن في انتشاره بين الشباب خصوصاً، فأعمال العنف التي ينخرط فيها بعض الشباب تدل بشكل صريح على عمق تعثر العقل في مقابل الغريزة، ومن ثم عمق تعثر الحب والتسامح وقبول الآخر في مقابل الكراهية والتعصب وإقصاء الآخر (بل تكفيره)، ولسنا في حاجة إلى تقديم دليل على ذلك، فأمامنا أدلة قاطعة تتمثل في الطريقة التي يعبّر بها هؤلاء الشباب عن آرائهم، فإذا عبروا كلاماً فاض خطابهم بعبارات الكراهية والاستبعاد وتبرير الممارسات العنيفة على أسس أيديولوجية وبث الفتاوى الدينية المبرِّرة للعنف، بما يتضمنه ذلك من هدر للجوانب الإنسانية والأخلاقية للدين، وإذا عبروا عن آرائهم سلوكاً، يتجهون إلى العنف وتدمير البيئة والممتلكات العامة والقتل من دون تمييز. ولا تكمن الخطورة فقط في ما ينتج عن هذا الخطاب وتلك الممارسات من كراهية مضادة ورفض واستبعاد، لكنها تكمن أيضاً في انتشار هذا النمط من التفكير بين قطاعات من أجيال المستقبل وتزايد انتشاره يوماً بعد يوم. وتكمن الخطورة الأكبر في إمكان انتقاله من حقل العمل السياسي المصطبغ بالدين إلى حقول أخرى من العمل السياسي، وإمكان وجود ردود فعل من المجتمع تواجه العنف بالعنف. عند هذا الحد نستطيع أن نختم بالقول إن وجود هذا النمط من العقل الجامد المتعصب وانتشاره بين قطاعات من الشباب (وإمكان انتشاره وتفشّيه)، يجعلان المشكلة التي نحن بصددها ليست مجرد اختلاف سياسي أو تخلف اقتصادي، بل هي أيضاً مشكلة اجتماعية وثقافية.
إنها مشكلة نظام اجتماعي تُرك فريسة لتطور عشوائي فتفرقت به السبل. وأحسب أن الوعي بذلك يمكّننا من نقطة البداية في تشكيل ناظم جديد لحياتنا.
أحمد زايد – الحياة اللندنية .