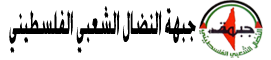ما عاد مجدياً وضع الملامة على الغرب فيما نحن نستنجد به لحل ّمشكلاتنا. نحن المسؤولون بالدرجة الأولى عمّا يحدث لنا، إلا إذا كنا نؤمن بأننا لسنا جديرين بمعالجة أزماتنا وإدارة شؤوننا.
لننصت إلى ما قال بعض أئمة المساجد والمشرفين على الجمعيات الإسلامية في فرنسا، سواء بعد مجزرة الصحيفة الساخرة، أو بعد الاعتداءات الأخيرة في تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم. فهم لم يفسّروا ما جرى بوصفه ردّاً من جانب الجهاديين على الحرب التي تشنها فرنسا على هوية المسلمين وثقافتهم وحضارتهم، ولم يردوا الظاهرة الجهادية إلى كون المسلمين الفرنسيين محل تمييز أو إقصاء ثقافي أو مجتمعي، بل قالوا عكس ذلك بالتمام.
لقد أكدوا أنّ بعض الجهاديين تعلموا في مدارس فرنسا أو تخرّجوا من جامعاتها ولم يكونوا فقراء أو محل إقصاء. كما أكدوا من جهة ثانية أن الإرهابيين هم صنيعة الجالية المسلمة في فرنسا بمؤسّساتها ومساجدها وثقافتها. وهكذا اعترفوا بمسؤوليتهم عن الكارثة، ومعنى اعترافهم أنهم لم يحسنوا إعداد أبنائهم لكي يندرجوا في المجتمع الفرنسي. ولذا لم يصبح هؤلاء فرنسيين، ولم يعودوا مسلمين تقليديين كأهلهم، أو مسلمين منخرطين في العالم الحديث يتعاملون مع هويتهم الدينية كشأن شخصي لا أكثر، وكما يفعل الفرنسي الكاثوليكي.
هذا الفراغ الهوياتي لدى الأجيال الجديدة من المسلمين الفرنسيين ملأته جرثومة التطرف التي زرعت في العقول منذ أكثر من قرن، والتي عبرت عن نفسها بأشكال ونسخ مختلفة، عبر موجاتها المتلاحقة، من بعض الحركات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية، لدى هذا الفريق أو ذاك. هذه الفكرة التي وعدت المسلمين بالخلاص، للتحرر من الهيمنة والتغريب، وللنهوض من الكبوة لكي يستعيدوا قوتهم ومجدهم على أساس ما تركه السلف من مقررات عقائدية وأحكام فقهية مبرمة لا تقبل المراجعة أو النقض، هي التي يترجمها الجهاديون أو المجاهدون، سواء لدى أهل الخلافة أو أتباع الولاية، إرهاباً وحشياً وحروباً أهلية أو غزواً للدول الغربية واعتداءات بربرية في هذه العاصمة أو تلك من عواصم العرب والعالم. فيا لها من صحوة ترجمها أصحابها بملء الأرض ظلماً وعدواناً.
ما صنعت أيدينا
لنعترف بما نصنعه بعلم أو بغير علم، فمجتمعاتنا بثقافتها وتقاليدها وعقائدها، هي خزان مولد للعنف الذي يتغذى من النرجسية القومية أو الدينية التي يقاوم أصحابها إرادة التغيير والتطور، لكي يستعْدوا العالم تحت شعار المقاومة والممانعة أو الحفاظ على الهوية. والمآل هو تدمير مصادر القوة لدى الشعوب العربية وشل طاقاتها الحية والخلاقة على إدارة شؤونها وقود مصيرها، على النحو الذي يتيح لها المشاركة في صناعة الحضارة.
لا شك في أن الأنظمة السياسية مسؤولة عن انفجار العنف وانتشار الإرهاب، أولاً لكونها تُمسك بمخالب السلطة وتستند إلى ورقة الشرعية المزيّفة. ثانياً لكونها انبنت على أساس إرهابي قوامه امتلاك الحقيقة وممارسة التألّه والوحدانية في ما يخص علاقة أصحاب هذه الأنظمة بالأوطان والشعوب. ولذا استخدم هؤلاء استراتيجية تقوم على خلق الأعداء، إنْ في الداخل لاتهامهم وترويعهم أو لاعتقالهم وتعذيبهم؛ أو في الخارج، تحت ذريعة محاربة هيمنة الدول الاستعمارية. هذا في الظاهر وعلى مستوى الخطاب، لكنهم كانوا يتعاملون مع تلك الدول في الكواليس والغرف المُعتِمة.
ولما انفجر الحراك الشعبي، بعد عقود من الاستبداد والفساد، سارع أرباب الأنظمة إلى اللعب بالورقة الإرهابية، بتوظيفها من أجل تبرير تشبثهم بالسلطة. ولذا كانوا يُلاحقون العناصر الإرهابية ويزجّونها في السجون من أجل تلميع الصورة والظهور، أمام العالم بمظهر المدافع عن الحداثة والعلمانية والحامي للأقليات الدينية من الجماعات الجهادية.
لكنهم أطلقوا سراح المجموعات الإرهابية وسهلوا لها مهماتها، عندما اقتضى الأمر ذلك، لكي تقف في وجه التظاهرات الشعبية السلمية. من هنا نحن إزاء ضدين متواطئين على تخريب البلدان العربية يجسدهما الطاغية والجهادي. كلاهما يتغذّى من الآخر بقدر ما يخدمه، وكلاهما يحتاج إلى ضده بقدر ما يدعي محاربته.
هل اللاعب الدولي مسؤول عمّا وصلت إليه الأحوال في العالم العربي؟ لا شك في ذلك، فالولايات المتحدة، وإن لم تكن مصدر الإرهاب أو صانعه، فقد دعمته واستخدمته في طوره الأول، وقبل أن يرتدّ عليها. وهذا شأن أكثر الدول الفاعلة على المسرح العربي، من عرب وغير عرب: فالواحدة منها تدعم الإرهاب في مرحلة وتحاربه في مرحلةٍ أخرى، أو تدعمه في مكان وتحاربه في مكان آخر، أو تمارسه وتصدّره ثم تدعي بأنها تحاربه.
كذلك الأمر في محاربة الاستبداد، إنهم يهاجمون أنظمته، لكنهم لا يُحسنون سوى التعامل معها أو دعمها، في السرّ أو العلن. ولذا فالكل يتخبَّط بقدر ما يتردّد بين النقيض والنقيض. والكلّ متورِّط، بقدر ما ينتقل من مأزق إلى مأزق. والكل متواطئ، لأن الواحد لا يخدم إلا ضده ومن يدعي محاربته. وتلك هي المفارقة الفاضحة.
والشاهد هو ما يجري في سورية بشكل خاص. وذلك حيث اللاعبون، يعملون لإنقاذ النظام وتنظيم «داعش» معاً، بمحاربة كل القوى والتنظيمات المعارضة لهما. فيا لها من حرب مزعومة ملغومة على الإرهاب، حصيلتها التطهير المذهبي وتهجير السكان لتغيير الخريطة الديموغرافية والطائفية لبعض البلدان العربية. نحن إزاء لعبة خبيثة، جهنمية، تدور فيها الدوائر على العرب الذين يجتمع عليهم الكلُّ، من فُرس وكردٍ وتُركٍ وروسٍ، فضلاً عن الأميركيين والأوروبيين. أما الأخطر والأدهى، فهو أن بعض العرب يتواطأون ضد «الشقيق» الذي بات العدوّ الأول، لمصلحة غير العرب، ولا عجب أن تكون النتيجة هي الدمار الذاتي والفناء المتبادل.
سقـــوط بـــعض الثــنــائـــيات الأيديولوجية، القومية والدينية أو الجغرافية، التي فقدت صدقيتها، كثنائية الإسلام والغرب أو العرب وأميركا أو الشرق والغرب… مثل هذه التقسيمات لا تنتج إلا الصدامات والعداوات والحروب، فالمجتمعات والدول أخدت تنخرط في واقع كوني، كوكبي، تتعولم فيه المعلومات والمكتسبات، بقدر ما تتعولم المشكلات والهويات، فضلاً عن عولمة الأفكار والثقافات. وإلا كيف نفسر أن شباناً فرنسيين عريقين ينضمّون إلى الحركات الجهادية التي تُعلِن الحرب على فرنسا؟ ليس الأمر مجرد إحباط أو مرض أو آفة. إنها عولمة الأفكار والنماذج. مَن كان يتخيّل أن المصلّين في إحدى الكنائس الفرنسية، يحتاجون ليلة عيد الميلاد إلى شبّان مسلمين لحمايتهم من خطر الاعتداءات الإرهابية؟!
لنحسن قراءة ما يحدث، فالواقع بات أكثر تنوعاً وتعقيداً وأكثر اختلاطاً وتشابكاً، مما نظن ونحسب، بعد أن اتسعت حركة الانتقال بين البشر، وبالأخص إلى أوروبا التي شهدت في العام الفائت، بسبب الحروب العربية، موجات متلاحقة من المهاجرين واللاجئين لم تشهد مثلها منذ الحرب العالمية الثانية. ولذا لم تعد توجد مجتمعات صافية ومتجانسة، فالصفاء هو وهم يولد التعصب والنزاعات.
هذا التغيُّر في المعطيات، على المستوى العالمي، يخربط الحسابات ويغير الخرائط والمعادلات، السياسية والإستراتيجية، بقدر ما يغير شبكات القراءة وأدوات التحليل أو منظومات الإدراك وأنماط السرد، في ما يتعلق بفهم الواقع وتشخيصه أو بوعي الذات وتشكيل الهويات.
من هنا نتعدّى اليوم القسمة بين مسلم وأوروبي، أو بين عربي وغربي، أو بين يساري ويميني… إذ هي تنطوي على قدرٍ كبير من الخداع والتبسيط. ثمة قسمة أخرى تفتح الإمكانات لبناء علاقات بين الدول والمجتمعات على أساس التفريق بين بربري ومدني، أو بين فاشي وديموقراطي، أو بين أصولي وليبرالي، أو بين عنصري وكوسموبوليتي، ولا أنسى القسمة بين سماوي وأرضي.
نحن إزاء نمطين توجد نماذجهما في كل الأزمنة والأمكنة. والفرق بينهما هو كالفرق بين صاحب الهوية المغلقة التي تمارس على سبيل التعصب والتطرف، أو الفقر والتخلف، وبين صاحب الهوية المركبة والملتبسة التي هي مفتوحة على تعدد الوجوه والأطوار والأبعاد، بقدر ما تمارس كهوية عابرة لحدود الدول وحواجز الثقافات. ولا يعني كونها عابرة أنها تذوب وتضمحل في الآخر. بالعكس، إن الهوية المغلقة على ثوابتها، هي التي ترتد في هذا الزمن، على صاحبها لتخلق له المشاكل والمآزق. ولا شك في أن أوروبا، التي نتهمها بالعنصرية، تُقدِّم مثالاً بانفتاحها وتضامنها مع اللاجئين، لكي تفضح عنصرية بعضنا تجاه بعض.
الإنسان هو فضائحه
إذا كانت أحوال العالم تتّسم، على المستوى الاستراتيجي، بالتخبّط والتورّط، فإنها تتسم على المستوى الوجودي، بالهشاشة والعجز، وكما تشهد المشكلات المتراكمة والمزمنة في غير ملف وغير قضية، من أزمة الديموقراطية إلى تفاقم الظاهرة الإرهابية، ومن الانهيارات المالية إلى قصور العقلانية الحديثة، ومن الفضائح الخلقية إلى تلويث البيئة. والأساس في ذلك هو فقدان الإنسان سيادته على نفسه وعلى أشيائه وصنائعه، بعد قرون من انبجاس النهضة الحديثة بشعاراتها التنويرية والعقلانية والتحررية. لنتوقّف عند فضيحة «الفيفا» كما جسدها بطلاها بلاتر وبلاتيني، فهي رمز لفضيحة الإنسان في هذا العصر. إنه النجم الذي يصعد بنرجسيته ويتستّر على انتهاكاته.
لعلّ الإنسان بات ينوء تحت رغباته وأهوائه أو تحت مطامحه وأحقاده، التي باتت تفلت من سيطرته أو تفوق قدراته بكثير، من فرط نرجسية الأنا وتضخّم الذات وطغيان النزعة الفردية. الأمر الذي يترجم في هذا العجز عن حلّ المشكلات وإدارة الشؤون، إلا على سبيل التسويات الهشة أو الموقتة، التي هي أشباه أو أنصاف حلول أو نوع من الهدن الموقتة التي تنتظر ساعة الانفجار.
هل أنا متشائم؟ لا أنكر أنه قد حصلت في العقود الأخيرة تحولات كان لها أثرها الإيجابي والبناء. أشير بالدرجة الأولى إلى بروز المرأة كشريكة للرجل في غير مجال أو قطاع، بما في ذلك المعترك السياسي، وهذا أثر من آثار الانتقال من عصر العضلة إلى عصر المعلومة.
أشير أيضاً إلى ظهور الدول الناشئة التي حققت قفزات نوعية، في الاقتصاد وفي البحث العلمي أو في التحوّل نحو الديموقراطية، كاسرة بذلك احتكار الغرب، فاتحة المجال للتعددية، سواء في نماذج التنمية أو في مراكز الإنتاج العلمي، أو في تعدّد الأقطاب واللاعبين في السياسة والاستراتيجية.
ولا شك في أن تونس تحضر هنا كاستثناء عربي، إذ هي نجحت في تداول السلطة وفقاً لقواعد اللعبة الديموقراطية، وصاغت دستوراً يحترم حرية الاعتقاد والضمير ويمنع إطلاق الفتاوى التكفيرية. والأمل أن ما جرى من تغيير يعبّر عن قناعة حقيقية، ولا يكون مجرد تكتيك سياسي.
ولا أنسى بلدي لبنان، الذي كان استثناءً في نظامه الديموقراطي الليبرالي، قبل أن تجري محاولات تعريبه وأسلمته لتعطيله وتخريبه. ومع ذلك فما زال النظام اللبناني العميق، الذي يسيّر حياة الناس، ويشكل مركز جذب لأكثر العرب، بمن فيهم الذين ينتهكون قوانينه، أقوى من الأنظمة الشمولية والديكتاتورية التي استهدفته، والتي تصدع بعضها وينتظر الآخر مصيره البائس.
وبالإجمال، إن لثورة التقنيات والمعلومات أثرها الفعال والعميق في تغيير وجوه الحياة وأنماط العلاقات بين البشر، فقد افتتحت معها إمكانات للتعبير والتحرك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى نحو يتيح فضح أو تعرية ما يمارسه أصحاب السلطات والدعوات والمشاريع من أشكال المصادرة والاحتكار، أو من آليات الحجب والزيف، أو من ضروب التشبيح والشعوذة. ولا عودة إلى الوراء إلا إرهاباً وحروباً.
ولذا لا تجدي، بعد كل هذه الأزمات الكيانية ووسط كل هذه التحولات الجذرية، إدارة العالم بالعقليات المفخخة والعقول القاصرة ذاتها، أو بالمقولات المستهلكة والنماذج العقيمة ذاتها. لا مهرب من مراجعة جذرية بدايتها كسر الأصنام العقائدية والتحرر من التنانين الأيديولوجية والتهويمات القدسية. من غير ذلك نبقى أسرى هوياتنا، أو سجناء أفكارنا، أو عبيداً لأصولنا، لكي نمارس الإرهاب، أقله على المستوى الفكري.
كفانا ابتزازاً وإرهاباً باسم الدفاع عن الهوية والثوابت لكي نحصد كل هذه المساوئ والكوارث. إن صاحب الهوية الحية والغنية، القادرة والبنّاءة، هو الذي لا يستعبده اسم أو أصل ولا يستعمره مذهب أو نموذج.
ومن هذا شأنه لا يدعي احتكار الحقيقة، سواء تعلقت بمبدأ أو شعار أو وطن… بل هو لا ينفك يخلق الوقائع والحقائق، في مجاله ومحيطه وعالمه، لكي يتجدد ويتحول، بالتعاون والتشاور والتداول مع سواه، في ضوء التجارب والتحولات أو على وقع الأزمات والتحديات.
هذا هو الرهان: أن نتحرر من الأفكار التي تجعل منا مجرد امتداد أو أدوات أو تبع أو خدم لأصول وتراثات أو لرموز وشعارات، لكي تصنع منا نماذج إرهابية بقدر ما تحيلنا إلى مشاريع قتلى. لسنا آلهة ولا أنصاف آلهة، لا ملائكة ولا أبالسة. وإنما كائنات تتسم بالتناهي من حيث العلم والقدرة، ما يحثنا على التواضع وعلى تدريب أنفسنا على قبول من ليس على شاكلتنا، بحيث نتقن فن التهجين والتركيب، لكي نحسن العيش معاً على سطح هذا الكوكب، بوصفنا كائنات أرضية لا تنتظر الخلود، شأنها بذلك شأن كل ما يحدث في هذا الكون، مما هو متغير وطارئ أو عابر وزائل.
الحياة اللندنية