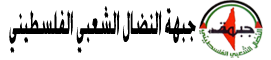تروَّج في مصر الراهنة مجموعة من الأساطير التي بات تفكيكها ضرورياً، قبل أن تفرض نفسها على الألسنة والعقول وتسهم في تشويه المعرفة والإدراك.
(1)
كان الدكتور أحمد عبدربه أستاذ العلوم السياسية سبّاقاً في تلك المحاولة، إذ نشرت له جريدة «الشروق» قبل عامين تقريباً (في 6 نيسان العام 2014) مقالة كان عنوانها «حروب الجيل الرابع: ربع قرن من الأساطير»، خلص منها إلى أن المصطلح الذي ظهر حديثاً في الخطاب السياسي المصري كان موضوعاً للمناقشة بين العسكريين الأميركيين، استهدفت هدم الفكرة وليس الترويج لها. واعتمد في تحليلها على ورقة نقدية من 30 صفحة نشرها في العام 2005 عسكري أميركي هو أنطونيو إيشافاريا كان عنوانها «حرب الجيل الرابع وأساطير أخرى»، وفي ورقته خلُص إلى أن «نظرية الجيل الرابع ما هي إلا تبرير للفشل المخابراتي والعسكري الأميركي، وتعبير عن عدم الاعتراف بحقيقة تطور الفاعلين من غير الدول وضعف قدرة الدولة على احتكار وسائل العنف التقليدية وغير التقليدية أمام عالم متعولم وشبكات علاقات بين فاعلين قادرة على تخطى الحدود التقليدية». لذلك فإنه دعا العسكريين الأميركيين إلى التخلي عن وهم النظرية والاعتراف بدلاً من ذلك بأن ثمة واقعاً جديداً على الدولة القومية الاعتراف به والبحث عن وسائل غير تقليدية لمواجهته ـ كما أنه حذر من الأضرار الجسيمة على الأمن القومي الأميركي، إذا ما تبنى الأكاديميون والمثقفون أمثال تلك الأفكار التآمرية بديلاً عن الفكر التحليلي النقدي. الدكتور عبدربه بنى على ذلك بعض الاستنتاجات التي كان منها أن الفكرة سُحبت من سياقها الأصلي كنظرية عسكرية أميركية تبرر فشل مواجهة الحركات الجهادية والإرهابية غير التقليدية إلى سياق سياسي مصري أريد به تبرير وقوع الثورات والإضرابات والتظاهرات.
سار على الدرب ذاته الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع في مقالة نشرتها له صحيفة «المصري اليوم» في 30/4/2016 كان عنوانها «خرافة هدم الدولة المصرية». والعنوان يعبر عن معارضته للفكرة التي لم يسمع أحد بها من قبل. حتى بعد عزل الملك فاروق أو الرئيس الأسبق حسني مبارك. حيث لم يعد ذلك هدماً للدولة، وإنما استخدم المصطلح لأول مرة على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي وأرجع ذلك إلى أنه «كان يقصد به نظامه ويحاول تحصين موقعه الرئاسي في مواجهة آخرين».
ليست جديدة إذن محاولة ضبط تلك الأساطير التي لفتت انتباه نفر من الباحثين. إلا أنه بعدما كثرت الأساطير المماثلة وتحولت إلى ظاهرة، فإنها صارت بحاجة لجهد خاص إن لم ينجح في وقف الموجة، فعساه ينبه إلى ثغرات مصطلحاتها وخطورة الانسياق وراءها، على الصعيدين السياسي والثقافي.
(2)
أبدأ من حيث انتهى الدكتور سعد الدين إبراهيم لأن مصطلح «الدولة» صار الأوفر حظاً من الانتهاك والابتذال. ذلك أن مصطلح هدم الدولة أو إسقاطها أصبح يستخدم كثيراً لإدانة ووصم أي تحرك لا ترضى عنه السلطة، ومن ثم تسعى لتعبئة الرأي العام ضده. كما رُفعت في مصر أخيراً راية «دعم الدولة»، التي صارت عنواناً لائتلاف داخل مجلس النواب. ناهيك عن أن الدولة صارت تُختزل في نظامها أو في رئيسها، بحيث غدا أي نقد للنظام أو لرئيسه يعتبر هجوماً على الدولة وسعياً لإسقاطها. وفي كل ذلك فإن الدولة في مفهومها الأصيل تصبح مظلومة ومفترى عليها.
الدولة في أي مرجع سياسي أو قانوني هي مجموع مكونات تتمثل في الشعب والأرض والنظام الذي يطبق القانون ويمارس السيادة. وهو توصيف يسقط مختلف الصياغات المتداولة التي يُزج فيها باسم الدولة ويقحمها في المعترك السياسي، فالتظاهر مهما بلغ لا يعدّ هدماً للدولة، ولكنه يظل في كل أحواله تعبيراً عن الاحتجاج أو حتى الاحتفاء الذي يستهدف النظام ولا علاقة له بكيان الدولة، وكذلك نقد السلطة كمنظومة أو الرئيس كشخص أو سياسة، ذلك كله يظل موجهاً للنظام بالدرجة الأولى. وتعدّ نسبته إلى الدولة من قبيل التهويل أو الادّعاء الذي يفتقد إلى الأساس الموضوعي والعلمي. من هذه الزاوية فإن إقامة كيان برلماني يُنسب إلى «دعم الدولة»، يعدّ من قبيل الافتعال والتدليس، حيث يصبح العنوان في هذه الحالة بمثابة قناع يراد به التستر على مهمة مساندة النظام والدفاع عن خطواته وإجراءاته.
يسري ذلك بالقدر ذاته على مصطلح استهداف الدولة، الذي يراد به الاستنفار وتعبئة الرأي العام بدعوى أن وجود الدولة أصبح في خطر، في حين أن الاستهداف موجه إلى النظام. وهو ما لا يعني أنه في هذه الحالة مرحب به، ولكنه يعني فقط ضبط المصطلح ووضعه في إطاره الصحيح.
يتصل بما سبق ذلك الجهد الإعلامي الذي يبذل لترويج مصطلح التآمر على الدولة الذي أصبح يطلق على أي تحرك معارض في داخل مصر أو خارجها، وقد فندتُ في مقام سابق ادّعاء التآمر الذي صار يتردد في كل مناسبة، ومما قلته إن تآمر الجهات الخارجية على مصر في مراحل سابقة حدث حين كانت القاهرة مؤثرة على محيطها ومنحازة إلى حركات التحرر الوطني بما يجعل أداءها ضاراً ومهدِّداً لمصالح الدول الكبرى، فضلاً عن أن عداءها لإسرائيل كان مستحكماً. وهي اعتبارات لم يعد لها وجود في الوقت الراهن الذي فقدت فيه مصر تأثيرها وتغيرت سياساتها، الأمر الذي بات يدفع الدول المعنية إلى السعي للحفاظ على استقرارها وليس للتآمر عليها ــ إلا أن خطابنا السياسي والإعلامي ظل يؤْثر التلويح بفكرة المؤامرة في وصف تحركات المعارضين المصريين في الخارج، للضغط على حكومات الدول التي تستقبلهم كما تستقبل غيرهم من المعارضين، ليس لأنها تؤيدهم ولكن لأن أجواء الحرية والديموقراطية التي تعيش في ظلها تلك الأقطار تحتمل استقبال أنشطة من ذلك القبيل عند حدود معينة.
إذا اعتبر أن الهدف من الترويج لشعارات التحذير من إسقاط الدولة والتآمر عليها هو إسكات المعارضين وتخويفهم، فإننا نضم إلى اللائحة، شعار رفض إهانة القوات المسلحة أو الشرطة. إذ بمقتضاه فُرض على المجتمع أمران، أولهما اعتبار المؤسستين فوق المساءلة والحساب وفوق القانون. الثاني إسكات أصوات المعارضين باعتبار كل نقد لأي منهما يعرف بأنه «إهانة»، يحال أمرها إلى القضاء العسكري، وما أدراك ما هو!
أدري أن هناك أسراراً عسكرية ليس لأحد أن يخوض فيها، وبذات القدر فإنني أفهم أن احترام المؤسستين لا يعني أن يظلا فوق النقد أو المساءلة، بما يحولهما إلى نموذج للأبقار المقدسة كما يقول التعبير الشائع. وبسبب تلك الحصانة غير المبررة خصوصاً الأنشطة المدنية فإن المؤسستين تحولتا إلى استثناءين بين مؤسسات المجتمع، الأمر الذي حولهما إلى دولتين شبه مستقلتين داخل الدولة.
(3)
في سفر الأساطير تطل علينا عناوين أخرى تتحدث عن أهل الشر والشعب الرافض لهم والحرب التي تخوضها مصر ضدهم.. إلى غير ذلك من صياغات الشيطنة والشعبوية التي تتلاعب بمشاعر العوام وتشوه وعيهم، بل وتفسد الحياة السياسية أيضاً. ذلك أن مصطلح أهل الشر يعيدنا إلى الوراء كثيراً، فيذكرنا بخطاب الاستعلاء السياسي الذي عبّر عنه الرئيس بوش بعد أحداث أيلول وخطاب جماعات التطرف الديني الذي دعا إلى المقابلة بين دار الإسلام ودار الكفر. وفى الحالتين فإنه يمثل انتكاسة لمفهوم المواطنة التي في ظلها يتساوى الجميع أمام القانون. والمفاضلة بين الأشرار والأبرار بينهم لا تتم بمعيار سياسي ولكنها تقاس بمعيار الالتزام بالقانون أو الخروج عليه.
اتصالاً بما سبق فإنه يحلو لأهل السياسة وأبواقهم الإعلامية الادّعاء بأن الشعب يريد كذا أو يقبل بكيت، ذلك أن الشعب في الدولة الحديثة ليس زعيماً ولا هو قناة تلفزيونية ولكنه مؤسسات تعبر عنه خصوصاً تلك التي تتشكل من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، إذ تلك وحدها التي يمكن التعويل عليها باسم الشعب. وكل ما خلا ذلك يُعدّ افتعالاً وانتحالاً يتمسح في الشعب ويتخفى وراءه.
أسطورة الحرب ضد الأشرار من أغرب ما يروج له في هذا السياق. ولا تكمن غرابتها في أنها طاردة بصورة تلقائية للاستثمارات المرغوبة لأنه ما من عاقل يستثمر أمواله في جبهة قتال، ولكن أغرب ما فيها أنها حرب افتراضية بولغ فيها لتسويغ الطوارئ وتقييد الحريات. وأصلها لا يتجاوز اشتباكات ومشاغبات لا تتجاوز حدود سيناء في الأغلب، في حين أن حوادث المرور أكبر منها بكثير في بقية أنحاء مصر.
(4)
أختم بأسطورتي المجتمع المدني والمصالحة الوطنية في مصر. ذلك أن المجتمع المدني لا يقوم بنص في الدستور احتفى به كثيرون واكتفوا به. وتجاهلوا أنه مجتمع المؤسسات المستقلة التي تقام على الأرض وتشترك في صناعة القرار السياسي والتعبير عن حقوق الناس ومراقبة أداء السلطة التنفيذية. وبعض تلك المؤسسات مقامة في مصر فعلاً ولكنها إما ملحقة بالسلطة أو معطلة الوظيفة. ومن المفارقات أن المظهر الأبرز للمجتمع المدني في مصر، المتمثل في المنظمات الحقوقية، أصبح هدف الملاحقة والاتهام والقمع بمختلف صوره.
تبقى مسألة الوحدة الوطنية المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أعلنت في 3 تموز في مشهد إعلان ميلاد النظام الجديد وهو الشعار الذي أطلق في الفضاء السياسي وحولته الممارسة إلى أسطورة نسمع بها ولا نرى لها أثراً. إذ كما أجهضت فكرة المجتمع المدني فإن تطبيق ذلك البند ظل محصوراً في جماعات الموالين والمحبين مع إقصاء غيرهم بمختلف الحيل والذرائع. في حين أنني أفهم أن الوحدة الوطنية الحقيقية هي التي تجمع شتات الأمة، من تحبهم فيها ومن تكرههم، طالما توافق الجميع على احترام الدستور والرغبة في العيش المشترك.
ليست هذه كل الأساطير الرائجة في زماننا، لأن في الجعبة الكثير مما تبثه وسائل الإعلام الموجه كل حين. ذلك أن فنون الالتفاف على الديموقراطية لا حدود لها. فضلاً عن أن قوة التأثير الإعلامي تغري بمواصلة تسويق الأساطير والاطمئنان إلى مفعولها. وتلك صفقة تدوم لبعض الوقت، لكن سنن الكون تعلمنا أنها لا تستمر طول الوقت. وأنه كلما طال الوقت زادت الكلفة وتضاعف الثمن. وهو ما ينبغي أن يقلقنا، لأن ثمناً باهظاً ينتظرنا فيما يبدو.
السفير