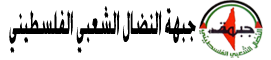واشنطن، العاصمة – في خطاب تنصيبه الأول، وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما الدعوة إلى البلدان الأكثر انغلاقاً في العالم، قائلا: “سوف نمد إليكم يدا، إذا كنتم على استعداد لإرخاء قبضتكم”. وقد لخص هذا التصريح السياسة الخارجية القائمة على “المشاركة” والتي انتهجها خلال فترة ولايته الأولى -وهو النهج الذي يتمتع بقدر كبير من الجدارة والتميز، على الرغم من بعض أوجه النقص والقصور.
لقد رفض أوباما سياسة عزل “الدول المارقة” التي تبناها الرئيس الذي سبقه جورج دبليو بوش. فقد أدرك أن الأمل الوحيد للتأثير على سلوك الدول المعزولة كان الانخراط بشكل مباشر معها في سياق ثنائي. وبوصفها استراتيجية ثنائية أثبتت المشاركة نجاحاً مذهلا، حيث أدت إلى انفتاح تاريخي، أولاً مع ميانمار والآن مع كوبا، في حين دفعت عجلة التقدم نحو اتفاق نووي دائم مع إيران. لكن إدارة أوباما أوضحت منذ البداية أن المشاركة ليست غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق أهداف متعددة، على المستويين الثنائي والإقليمي.
في ميانمار، كان الهدف الثنائي يتلخص في دفع الحكومة نحو المزيد من الانفتاح والديمقراطية، وهو الأمر الذي حدث بلا أدنى شك. فقد أطلِق سراح الزعيمة المنادية بالديمقراطية والحائزة على جائزة نوبل، أون سان سو تشي، من الإقامة الجبرية؛ وفاز حزبها بمقاعد في البرلمان؛ والآن يدرس الملايين من أهل بورما دستور بلادهم وقدموا التماسات لتعديله.
من المؤكد أن الطريق ما يزال طويلاً هناك. ويصف الصحفي مارتن وولاكوت ميانمار بأنها “منزل على منتصف الطريق بين الحكم العسكري والحكم المدني”، مشيراً إلى أن الجنرالات وعدوا باستكمال الانتقال إلى الديمقراطية لسنوات طويلة، غير أنهم ليسوا راغبين حتى الآن في السماح لسو تشي بالترشح لمنصب الرئاسة.
لكن هذا لا ينبغي أن يحجب التقدم الذي تم إحرازه؛ فمقارنة بالعام 2009، عندما تولى أوباما منصبه، تغيرت ميانمار وسياستها إلى حد كبير. وفي حين من المرجح أن يعترف أوباما بأن سياسة الولايات المتحدة لم تجلب هذه التغيرات (التي تحققت نتيجة لعملية داخلية من إعادة الحسابات من قِبَل الرئيس الجنرال ثين سين)، فإن الولايات المتحدة كانت مستجيبة ومرنة بالقدر الكافي لتشجيع التغيير.
على الجبهة الإقليمية، كان أوباما يأمل أن يضمن الانفتاح على ميانمار عدم اعتمادها بشكل كامل على الصين، في حين يمكِّن الولايات المتحدة من تعميق علاقاتها برابطة دول جنوب شرق آسيا. وكان استئناف العلاقات مع ميانمار أحد المقومات الحاسمة لمبدأ “إعادة التوازن نحو آسيا” الذي تبنته إدارة أوباما.
أما في حالة كوبا، فيبدو أن الهدف الأولي يتلخص في تعزيز احترام حقوق الإنسان في التعامل مع المواطن الكوبي العادي، وليس تغيير النظام. وعلى الرغم من أنه ما يزال من المبكر للغاية أن نحاول تقييم تأثير هذا الانفتاح من حيث الحد من القمع، فإن الفرصة التي يقدمها لمواطني كوبا للتواصل مع الأميركيين، أسرة لأسرة أولا، ثم شركة إلى شركة، تبقى بالغة الأهمية.
على المستوى الإقليمي، تستحق استعادة أوباما للعلاقات مع كوبا مكاناً في كتب التاريخ إلى جانب انفتاح ريتشارد نيكسون وهنري كيسنجر على الصين. وعلى الرغم من أن هذا الزعم ربما يبدو متكلفاً، فإن عبور المضيق إلى كوبا يشير إلى نهج جديد أكثر انفتاحاً وإنتاجية للعلاقات مع كل بلدان أميركا اللاتينية.
على مدى العقد الماضي، وبسبب استمرار عزل كوبا، جنحت كل جهود قادة الولايات المتحدة لتأسيس أطر منتجة للتعاون المتعدد الأطراف مع أميركا اللاتينية -بما في ذلك محاولات إعادة تنشيط منظمة الدول الأميركية وبناء منتديات جديدة مثل قمة الأميركيتين. وكانت قمة الأميركيتين في قرطاجنة في العام 2012 قد تحولت إلى ممارسة لتقريع أميركا، مع تهديد البلدان بمقاطعة قمة 2015 إذا لم تتم دعوة كوبا لحضورها.
من حسن الحظ أن الولايات المتحدة ارتقت إلى مستوى التحدي، وبحضور كوبا على الطاولة، انعقدت القمة في بنما في موعدها. ونتيجة لذلك، أصبحت قمة الأميركيتين وغيرها من المنظمات الإقليمية في موضع أفضل لمعالجة الأزمات الإقليمية مثل الانهيار المقبل في فنزويلا، والفرص مثل إنشاء البنية الأساسية للطاقة والتجارة وإنفاذ القانون في نصف الكرة الأرضية الغربي.
من شأن الاتفاق النووي مع إيران أيضاً أن يخلف عواقب مماثلة من حيث الأهمية في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا -وهو الاحتمال الذي يفسر إلى حد كبير المعارضة الشديدة للمفاوضات من جانب إسرائيل والمملكة العربية السعودية. وفي حين أن الصفقة سوف تنجح أو تفشل تبعاً لمدى سحبها إيران بعيداً عن حافة الهاوية النووية، فإنها تفتح أيضاً الباب للمزيد من المفاوضات الثنائية بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، من إنهاء الحرب في سورية، إلى تضييق الخناق على تجارة المخدرات غير القانونية في أفغانستان. وبالفعل، أدت سياسة المشاركة التي ينتهجها أوباما إلى أكبر قدر من التفاعل الثنائي منذ الثورة الإيرانية وأزمة الرهائن في العام 1979.
أياً كانت مزاعم وادعاءات الحزب الجمهوري في أميركا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في العام 2016، فإن سياسة أوباما القائمة على المشاركة كانت ناجحة، حيث مكنت الولايات المتحدة من تشكيل الأحداث في أكثر البلدان انغلاقاً. فلماذا يواصل النقاد إذن مناقشة انحدار النفوذ الأميركي العالمي المفترض؟ (في الشهر الماضي، ظهر هذا الموضوع على الصفحة الأولى من صحيفة نيويورك تايمز، في مقال نَقَل عن مسؤول سابق في الخزانة قوله: “نحن ننسحب من المكان الأساسي الذي كنا نستحوذ عليه في الساحة الدولية”).
قد تكون الإجابة أن الخلل السياسي الداخلي أصاب الرئيس بعجز شديد في المفاوضات الدولية. على سبيل المثال، منع الكونغرس الأميركي تغيير مخصصات الحصص للبلدان في صندوق النقد الدولي. بل إن مجموعة من 47 من أعضاء مجلس الشيوخ كتبوا رسالة إلى قادة إيران يعلمونهم فيها أن الكونغرس التالي قد لا يحترم أي اتفاق نووي ربما يتوصلون إليه مع أوباما.
ثمة مصدر آخر للشك يكمن في تأثير أميركا الدائم في حقيقة أن المشاركة متعددة الأطراف ما تزال مطلوبة، وهي دائماً أكثر صعوبة من المفاوضات الثنائية. والواقع أن الزعامة المتعددة الأطراف لا تتطلب قواعد أكثر وضوحاً وجرأة فحسب، بل وأيضاً الرغبة المؤكدة في تحمل تكاليف هذه القواعد، سواء بخلق مناطق آمنة لدعم “المسؤولية عن حماية” المدنيين أو اتخاذ خطوات ملموسة للحد من حجم الترسانات النووية، وإزالتها تماماً في نهاية المطاف.
إن المشاركة الثنائية سوف تثبت كونها واحدة من أهم موروثات أوباما في السياسة الخارجية. ولكن ضمان قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار في القيادة في القرن الحادي والعشرين سوف يتطلب نوعاً مختلفاً من المشاركة. وسوف تكون تلبية هذا المتطلب من المهام الحاسمة المكلف بها الرئيس الأميركي القادم.
آن ماري سلوتر*
*المديرة السابقة لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية (2009-2011). أستاذة العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة برينستون.
*خاص بـ الغد، بالتعاون مع “بروجيكت سنديكيت”، 2015.