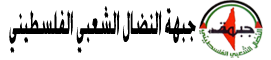القاهرة ـ «القدس العربي» عبد الدائم السلامي: لأنها مصرُ، فإن ما يحدث فيها يُلقي بظِلالِه على باقي أقطارنا العربية سواء بالسلب أو الإيجاب. ولأنها مصرُ، فإن لكل مواطن عربي الحق في الانشغالِ بما يمورُ فيها من قضايا، وله الحق في التأثرِ بما يُصيبُ منها جسدَها الوطني والقومي بكدماتٍ ثقافيةٍ وسياسيةٍ واجتماعيةِ غائرةٍ، لأنها ظلت وستظل الملجأ الآمنَ الذي يقصده المثقفون الذين عادَتْهم حكوماتُهم. وبسبب كل ذلك، حاولنا في هذا التحقيق الوقوف على هَناتِ الفعل الثقافي في مصر وإمكانات تعديله، عبر آراء نخبة من الفاعلين في المشهد الثقافي.
الثقافة ديكور حكومي
يذهب الشاعر والمترجم «رفعت سلام» إلى أن المثقفين المصريين ليسوا كتلةً واحدة، صماء. ذلك أن منهم مَن يتماهون مع النظام، ويصبحون جزءًا منه، بالقيام بالأدوار الموكلة إليهم من أعلى، دون أن يتخلوا في الوقت نفسه عن (الرطانة) اللفظية اللامعة أمام الميكروفونات ــ النموذج الأشهر في السنوات الأخيرة جابر عصفور وأحمد عبدالمعطي حجازي ــ ومنهم مَن يرأسون المؤسسات الثقافية، ومَن يرتبطون بعلاقات وثيقة بأركان النظام الحاكم، ومَن يحاولون الإمساك بالعصا من منتصفها، دون أن يقطعوا (شعرة معاوية) التي تأتي من ورائها منافع متفاوتة، ليست قليلة. وثمة جيش عرمرم من المثقفين الأكاديميين في كليات الآداب المترقبين دائمًا للكراسي البيروقراطية التي تخلو- أو ستخلو- في المؤسسات الثقافية، لعل وعسى أن يصيبهم الدور. وبطبيعة الحال، هناك مَن يختارون التمسك بحريتهم الكاملة، إزاء نظام يرونه فاسدًا وقمعيا باطشًا ــ النموذج الأشهر في السنوات الأخيرة صنع الله إبراهيم ــ ورغم أن المؤسسة الثقافية الحكومية تعيش حاليا أسوأ أوضاعها، في ظل نظام يعتبر الشأن «الثقافي» عبئًا بلا طائل، وغير مرغوب فيه، إلا أنها ما تزال- رغم كل التصدعات الظاهرة والخفية- فاعلة بدرجة واضحة. فما تزال هي الناشر الأول في مصر (هيئة الكتاب وقصور الثقافة)، ومانحة الجوائز الأعلى قيمةً مادية سنويا (المجلس الأعلى للثقافة). وقواعد النشر ليست صارمة تمامًا، بحيث يمكن النشر لمن يتخذ موقفًا منددًا ببطش النظام القمعي، أو فساده. لكن قواعد الجوائز والامتيازات المادية صارمة لأقصى حد، فهي مرهونة- في الأدب بالذات- إما بتوافقك مع النظام إلى حد الترويج، بطريقة أو أخرى له، أو بصمتك على ما يرتكبه، أو بفكرة طرأت في بال أحدهم بأن يجربوا شراءك ــ كما حدث مع تجربة صنع الله التي قلبها عليهم إلى فضيحة ــ والصامتون فئة عريضة في المجال الثقافي، يكتشفون كل يوم فضائل الصمت، رغم «النميمة» السياسية المضادة للنظام، التي يبوحون بها في الجلسات الخاصة. هي وضعية معقدة، ذات مستويات، وتفاوتات، وتنويعات متعددة. والأمر في النهاية مرهون بتوجهات النظام الحاكم، في دولة مركزية شمولية قديمة كمصر؛ هل يعتبر الثقافة مكونًا أساسيا لشعبه، أم إنها ديكور قد يتحول إلى عبء يحسن الخلاص منه، أو تقليصه إلى الحد الأدنى الممكن. كما يؤكد «سلام» على أن غالبية المؤسسات الثقافية الحالية تم تأسيسها في العهد الناصري، بروح الإحساس العميق بقيمة الثقافة. ورغم القمع السياسي، إلا أن هوامش من الحرية كانت متاحة في المجالات الثقافية، بما سمح بنهوض ثقافي في مختلف المجالات تقريبًا، وهي المؤسسات نفسها التي تعاني حاليا من الشيخوخة، وتعدد الأمراض المستعصية، بفعل نظرة النظام العسكري الحاكم الحالي إلى الثقافة، وتعامله معها على مضض، بل ربما بكراهية. فالدور المجتمعي للمثقف لا يمكن أن يتحقق في مواجهة الهيمنة الحالية للأجهزة الأمنية، وتحكمها في الأنشطة المختلفة، إلى حد إغلاق مكتبات أقيمت بالجهود الذاتية/غير الحكومية. وهي أجهزة لا تسمح – خاصة خارج القاهرة- بأي أنشطة ثقافية، إلا بقيود شديدة القسوة، تحبط القائمين على الأنشطة. فما حاجة نظام عسكري/بوليسي إلى الثقافة؟
الذين يأكلون «بَط الحظيرة»
الروائي «وحيد الطويلة» يرى أن مسألة التدهور الثقافي في مصر بدأت من الحظيرة، ذاك التعبير الوقح الذي تم إطلاقه أيام فاروق حسني، كثير من أتباع فاروق تحسروا عليه في ما بعد، ولكن لم يترحم أحد منهم على حرية التعبير، حتى الذين أكلوا «بَط الحظيرة» أداروا وجوههم وهم يحصون غنائمهم. ماذا تنتظر من عالم عربي مازال يَحكم ويُحكم بالعشيرة، بأساليبها التي فاقت أساليب القرون الوسطى؟! ويرى الطويلة أن الآفة تبدأ من «الشللية»، تلك التي تبدأ من تعيين كاتب أو شاعر في منصب ثقافي. كان عفيفي مطر – وهو الشاعر الكبير- يتحدث بمرارة عما حصده البياتي بقوله: «ربع شاعر حصل على حظ ألف شاعر». نتحسر دائما عما فعله السياسي بالثقافي على مدى أزمنتنا، لكن حين تسمع حاكما يُقصي المثقفين بجملة واحدة يقول فيها: «دُولْ بْتُوعْ تَنْظير»، عندها ستعرف موقع الثقافي والمثقف على الخريطة المصرية. لقد تم بيع المثقف لصالح نظرة أحادية تبتذله قبل أن تقصيه.
الشللية في أبرز تجلياتها تظهر في الجوائز حين ترى مؤسسة تحرص على أن تَمَثل بثلاثة أشخاص من خمسة في لجنة ما حتى تضمن منح الجوائز لأعضائها. الحالة تدعو إلى الرثاء والخوف على وطن لا يعرف من مبدعيه إلا أصحاب الشلل التي تسيطر على عقل شعب يُصَدق التلفزيون والحكومة، ومن يدور في فلكهما. الشللية المقيتة انتقلت من الهامش إلى المتن، إذْ تسمع بأسماء رنانة ولا تقرأ لها جملةَ واحدةً تُصْلِح من روحك أو تغذي عقلك. كنا نقول من قبل يجب أن نعلم الناس ليقفوا معنا، ولا أعرف إن كانت المقولة صالحة في ظل تصدر «المِدْيُوِكِرْ» لكل شي من قمة الهرم إلى أسفله حيث نقبع. أحد الذين يحصلون على منحة التفرغ بشكل دائم يريد الحصول عليها طوال العمر، ويقول – وهو يعد النقود: نعم، يجب أن نحصل على كل ميزانية وزارة الثقافة، أليست هي المسؤولة عن رعاية المثقفين؟ والمثقفون أليسوا هم من يُثقف الشعب؟ العوض على الله.
تدجين المثقف
الجامعي والقاص «خالد عاشور» يرى أن أزمة الثقافة المصرية تعود إلى أزمنة وزارات هشة حكمت الفعل الثقافي منذ بداية الثمانينيات وما بعدها، وجعلت المثقف المصري يعاني أزمة تدجينٍ ووضعٍ في حظيرة الوزارة بالترهيب أحياناً وبالتهميش أحياناً أخرى، أو برمي فتات الجوائز للبعض، وجعل البعض جواسيس على البعض الآخر، ما جعل دور وزارة الثقافة ذاتها في تقلص دائم، حتى ابتعد عنها المثقف الحر وبدأ يعتمد على النشر الخاص بعيداً عن المؤسسة الثقافية برمتها، إيثاراً منه للسلامة من القيل والقال، أو السير في ركب المؤسسة الثقافية الضعيفة أصلاً، وهو ما نتج عنه ظهور دور للنشر كبديل للمؤسسة الحكومية الرسمية تستقطب من تشاء هي الأخرى وترفض من تشاء، حتى أصبحت بعض دور النشر تتحكم في الجوائز، وتتحكم في المؤسسة الثقافية ذاتها في ما بعد لوجود مصلحة بين الطرفين أو لإلقاء المؤسسة الرسمية ممثلة في وزارة الثقافة العبء على دور النشر الخاصة لسوء إدارة الدولة ووزارة الثقافة وتحولها إلى مجرد وظيفة لموظفين يتقاضون مرتبات شهرية بعيدا عن الإبداع. كما يلاحظ عاشور وجود «تقلص في دور المؤسسة الثقافية وتحولها إلى مجرد مراسم واحتفالات وهبات وعطايا لجوائز الدولة ومنحها للمقربين، أو مجرد منحة نهاية الخدمة تقوم على إعطاء جوائز الدولة التشجيعية لمبدعين بلغوا من العمر ما يزيد عن الخمسين، غير أن الأسوأ في المنظومة الثقافية ذاتها تحول الوسط الثقافي المصري إلى «غيتوهات» منغلقة على ذاتها تخدم بعضها بعضا، حيث يتوجب أن يكون لك «شلة» تخدمك وتخدمها، شلة من الكتاب، شلة من النقاد، وكل «شلة» على خلاف مع غيرها، حتى أصبح حال المثقفيين المصرين صعبًا ولم تعد لهم أي كلمة، خاصة في القضايا الكبرى أو حتى بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي كان يأمل المثقف المصري أن تلقي بحجر في بركة راكدة، غير أن الحال يزداد سوءا وترديا، وعاد جل المثقفين إلى غيتوهاتهم مرة أخرى، فمن يملك بابا أو مساحة في جريدة له مجموعته، ومن يعمل في صحيفة مسئول فيها عن الإبداع – وهو في الأصل غير مبدع – أصبح له مريدوه ممن يُسَبحون بحمده، أو لهم غايات يريدون تحقيقها بفضله، فأصبحت الصحف الثقافية والمجلات الأدبية حكرا على المثقف المسؤول وشلته ممن يخدمونه ويدورون في فلكه، ربما يكون هذا المرض مستشريا في الوطن العربي كله، غير أنه في مصر يأخذ شكلا مرضيا، فكل مجموعة من المبدعين والمثقفين يكونون غيتو «شلة» وكل «شلة» لها خصوصيتها وعلى خصام مع من يعارضها، حتى أصبحت وزارة الثقافة ذاتها عبارة عن غيتو أكبر تستقطب من تشاء، وتستبعد من تشاء من عطاياها ومنحها ليتحول المشهد في النهاية إلى مشهد عبثي فقدت فيه مصر دورها الثقافي، بل وتَقَزم بشكل ملحوظ وصل إلى حد الموت الأكلينيكي، وهو أمر جعل المثقف يعول على مجهوده الشخصي، مبتعِدًا بذلك عن المشهد الثقافي العبثي نفسه، وعن المؤسسة الثقافية ذاتها وعن غيتوهات الوسط الثقافي لينجو بنفسه».
نزاهة المثقف شرط وجوده
ويقول الشاعر «فتحي عبد السميع» إن علاقة المثقف المصري بالسلطة والمجتمع تعاني أزمة معقدة، لا تعرقل دوره في بناء المجتمع فقط، بل تحاصره في زاوية ضيقة، وتجعله عرضة لتلقي الضربات الأليمة من الجانبين. تنبع الأزمة من التعارض بين طبيعة المثقف وطبيعة السلطة المهيمنة، ومن الهاوية المرعبة التي تفصل بين تلك السلطة والمجتمع. ويضيف بأن المثقف طاقة نقدية تنظر للمستقبل دائما، بينما السلطة تخاف من النقد وتحرص على بقاء الأوضاع كما هي، وتريد أن يتحرك المثقف في ظلها، وأن يدفعها هي للأمام لا المجتمع، بينما الحركة الطبيعية للمثقف تكون أمام السلطة وحولها لا خلفها، ويكتسب قيمته من الحوار الموضوعي مع الواقع، وغربلته أملا في الوصول إلى واقع أفضل، ولهذا انتقل الإنسان من العصر الحجري وظهرت الحضارات، ولولا تلك الحركة النقدية والإبداعية لتجمدت الحياة الإنسانية منذ ظهور السلطة المهيمنة على وجه الأرض، فالتنافر بين السلطة والثقافة عميق جدا، حتى أنه يتحول إلى صراع حياة وموت، لكن السلطة أكثر ذكاء من أن تضع نفسها في مواجهة المثقف بشكل علني، خاصة في ظل مشهد عالمي لم يتم حشد الجماهير فيه ضد المثقفين، بل على العكس، يظهر المثقف عالميا كعلامة من علامات التقدم والحرية. وعين السلطة كما هو معروف معلقة بذلك المشهد العالمي. وهكذا تظهر مودتها للثقافة على المستوى الخارجي، وتمارس نقمتها على المستوى الداخلي عبر مجموعة من الألعاب، ولا تلجأ إلى انتقام مباشر أو خشن كالسجن أو القتل إلا نادرا، ويبقى ذلك الانتقام من خيارات اللعبة. ومن تلك الألعاب عزل المثقف عن المجتمع بشتى الوسائل، وصنع أشباه مثقفين يحتلون مواقع المثقفين، أو فتح الباب للمثقفين في وقت معين وغلقه في وقت معين، وفق مصالح السلطة لا المجتمع، والأخطر هو تجفيف منابع المثقفين من خلال انحطاط مستوى التعليم والإعلام الذي نجح بشكل كبير في تقديم صورة مشوهة جدا للمثقف تباعد بينه وبين المجتمع، حيث يظهر في تلك الصورة مرادفا للشيطان المعادي للدين، أو الشخص المتهتك مدمن الموبقات. يتحرك المثقف في هامش صغير وبشكل فردي، ويعجز عن صنع حركة جماعية لأن السلطة لا تسمح بذلك أبدا، ولديها من الإمكانيات ما يسهل اختراق أي تجمع ثقافي وقتله في المهد أو تشويه مساره. ويختتم عبد السميع قائلاً إن موقف المثقف شديد الضعف، ورغم ذلك يمتلك قوة هائلة، تمكنه من لعب دور كبير في النهوض بالمجتمع، وتلك القوة تأتي من قوة الثقافة نفسها، وقدرتها على إحداث الفارق في مسيرة الإنسان، وهكذا ينبغي تقييم دور المثقف وفق طبيعة الثقافة لا السياسة، وعلى سبيل المثال، لا ينبغي أن نطلب حلولا سريعة من الثقافة، فالسياسي ينشغل بالثمرة الجاهزة، والمثقف ينشغل بالشجرة والتربة ومن ثم فتأثيره قوي وعميق ويحتاج إلى وقت، بخلاف السياسي الذي يهتم بالمسكنات أو ترقيع الثوب القديم.
وإن رد الاعتبار لدور المثقف إنما هو مشكلة السلطة ومشكلة المجتمع، أما مشكلة المثقف فهي الحفاظ على هويته من التلوث والفساد، دوره هو التشبث بنزاهته، وإخلاصه للثقافة لا للسلطة، وتطوير إمكانياته المعرفية دون كلل أو ملل.
صراعات وغيتوهات الثقافة المصرية في ظل نظام عسكري

Leave a comment