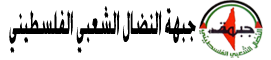غالباً ما توصف السياسة الخارجية السعودية بأنها تعتمد في أدائها أسلوب «الصمت الحذر»، وهي بطبيعتها تميل إلى تعمّد الغموض والإبهام، وتفضل الديبلوماسية السعودية في العادة اللجوء إلى السرية وتجنب المواجهة، وهي بهذا المعنى أقرب ما تكون إلى المواربة وأبعد ما تكون عن الأسلوب المباشر. تعتقد القيادة السعودية أن هذا الأسلوب هو الأسلم لها في تعاملها مع محيطها الإقليمي المباشر المليء بالصراعات والبعيد عن الاستقرار. وهي لذلك كانت تكتفي بإفساح المجال أمام حليفتها منذ أمد طويل الولايات المتحدة الأميركية لأن تتخذ المبادرات وتتابع جدول الأعمال الخاصة بها في الشرق الأوسط ويكون السعوديون موافقين غالباً.
في الواقع، تأسست العلاقات السعودية ـ الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية، وفي 18 شباط 1943 أعلن الرئيس الأميركي روزفلت «أن الدفاع عن السعودية يعتبر أمراً حيوياً للولايات المتحدة الأميركية»، وقد مهّدت شركات النفط الأميركية قبل عشر سنوات من إعلان روزفلت لتأسيس هذه العلاقات حين نجحت شركة «ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا» في الحصول على امتياز حق التنقيب عن النفط في المملكة العربية السعودية. ويُجمع المتابعون للعلاقات بين واشنطن والرياض على اعتبار أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي روزفلت مع الملك السعودي عبد العزيز بن سعود على متن الطراد (كوينسي) وهو في طريق عودته من قمة يالطا (شباط 1945) مع ستالين وتشرشل، قد وضع الأساس لصفقة استراتيجية قوامها ضمان تدفق النفط السعودي إلى الولايات المتحدة وحلفائها مقابل حماية واشنطن للنظام السعودي.
على مدى السبعين سنة الماضية، استمرت معادلة الحماية مقابل توريد النفط بأسعار معقولة. صحيح أن هذه العلاقات لم تخل في بعض المراحل من تباينات وتوترات بين الطرفين، لكن هذه الحالات شكلت الاستثناء لا القاعدة. وبحسب شاس فريمان الديبلوماسي المخضرم، والسفير الأميركي الأسبق في الرياض (1989 ـ 1992) خلال حرب الخليج الأولى، والشخصية المعروفة الوثيق الصلة بمؤسسات السياسة الخارجية الأميركية الذي يقول: «في الماضي كان باستطاعتنا أن نعتمد عليهم (السعوديين) على الأقل لعدم معارضة سياسة الولايات المتحدة، وفي معظم الأحيان تقديم الدعم لهم».
لكن هذا التوافق بين البلدين في هذه الأيام لم يعد قائماً بالوتيرة نفسها التي كان عليها في السابق، ويبدو متعثراً وعرضة لاهتزازات متعددة، وفي الآونة الأخيرة، خرجت شكاوى صاخبة عبّر عنها كبار المسؤولين السعوديين بوضوح بأن مصالح التحالف الوطيد بين البلدين باتت على المحك وهذا ما دفع بوزير الخارجية الأميركية جون كيري للقيام برحلة طارئة إلى الرياض أوائل تشرين الثاني الماضي قابل خلالها الملك عبدالله ووزير الخارجية سعود الفيصل وعدداً من المسؤولين السعوديين. لكنه من المشكوك فيه أن يكون كيري قد نجح في وضع حد للتدهور في العلاقات بين البلدين.
يتحدث دافيد اغناسيوس الكاتب المعروف في صحيفة الواشنطن بوست عن عملية انهيار في العلاقات السعودية الأميركية، «وأنها تسير نحو هذا المنحى منذ عامين، ويشبهها مثل سيارة في طريقها للتحطم بصورة بطيئة» ـ ولا يخلو هذا الوصف من المبالغة ـ غير أن باحثين أميركيين آخرين يذهبون إلى أبعد من ذلك، حيث يعتبرون أن ما آلت إليه العلاقات بين البلدين هو تتويج لمسار طويل يتمثل بخيبة أمل متبادلة وبطيئة، بدأت مع نهاية الحرب الباردة، وتضمنت محطات قاسية لكلا الطرفين. كانت «11 أيلول» 2001 بالنسبة للأميركيين واحدة من هذه المحطات، بينما شكّل غزو العراق (2003) وما نجم عنه على الأقل ـ بنظر السعوديين ـ من تسليم للسلطة من قبل إدارة جورج بوش الإبن، إلى الأغلبية الشيعية، وهذا ما شكل على الأرجح أكبر نكسة استراتيجية تعرضت لها المملكة خلال العقود الماضية.
بالطبع، لم يرق للرياض تبنّي إدارة بوش الابن حتى قبل غزو العراق الدعوة لنشر الديموقراطية في الشرق الأوسط، فهذا يمس عصباً حساساً لدى السعوديين، وقد حظيت هذه الدعوة بترويج أميركي لها بعد «11 أيلول»، وبذلك كان الجفاء يزداد بين الحليفين.
أما في ساحة الاشتباك الاقليمي في المشرق فكانت ايران هي الخصم الذي حاول السعوديون كبح نفوذه ومنع تمدده في منطقة يعتبرونها تقع ضمن جوارهم المباشر، ففي لبنان دعم السعوديون تحالف «14 آذار» للفوز مرتين متتاليتين في الانتخابات النيابية (2005 و2009)، وكان همّهم الأول كبح «حزب الله» حليف ايران، الذي استفاد من التوازنات اللبنانية ليحصل مع حلفائه على حق «الفيتو» في الحكومة اللبنانية بعد التوقيع على اتفاق الدوحة، ولاحقاً وجد تحالف «14 آذار» نفسه خارج الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي. وفي العراق، وبرغم الجهود التي بذلها السعوديون، لم يستطيعوا فرض خيارهم بتعيين اياد علاوي كرئيس للوزراء، رغم حصوله على أكبر كتلة في البرلمان العراقي، ليتسلم هذا المنصب، منافسه المقرب من طهران، نوري المالكي، الذي لا يزال في منصبه منذ انتخابات 2010.
وفي الساحة الفلسطينية، رعى الملك عبدالله اتفاق مكة بين حركتي «فتح» و«حماس» وكان أحد أهداف هذا الاتفاق إبعاد «حماس» عن التأثير الايراني، إلا أن الاتفاق سقط في غضون أشهر، بعد أن تولت «حماس» السلطة في قطاع غزة، وهذا ما جعلها لا تستغني عن علاقتها بإيران.
كل هذه المحاولات باءت بالفشل على مستوى المنطقة، فقد كان السعوديون منذ قرابة ثماني سنوات يمنون بالخسائر، في حين ان النجاح كان حليفاً لإيران على حد تعبير غريغوري غوس الخبير الأميركي في شؤون الخليج وشبه الجزيرة العربية.
وفي أعقاب أحداث «الربيع العربي» أوائل العام 2011، التي غيّرت توازن القوى في المنطقة، لم يكتم السعوديون ردود أفعالهم الغاضبة، وبطبيعة الحال كان تركيزهم على مصر أكثر من تونس، إذ شكّل سقوط مبارك خسارة لا تعوّض للسعوديين، الذين كانوا يرون في نظامه ثقلاً معيناً هم بأمس الحاجة إليه لموازنة القوة الإيرانية الصاعدة.
كانت الهوة تتسع أكثر فأكثر بين الرياض وإدارة أوباما؛ لدى السعوديين بواعث قلق حقيقية لأداء هذه الادارة، انها برأيهم تخطئ التقدير حول مخاطر «الربيع العربي» ومآلاته. وهي لا تراعي مصالحهم في تعاطيها مع الأحداث. لا يتصوَّر السعوديون أبداً أن يكون مصير ملك البحرين «آل خليفة» كمصير مبارك، لأن من شأن أي تغيير سياسي محتمل في البحرين أن يشكل خسارة للسعودية أمام إيران، ناهيك عن تداعياته المباشرة على السكان الشيعة في المنطقة الشرقية الذين سينتفضون على آل سعود في حال نجاح الانتفاضة في البحرين.
بناءً على ما تقدم، لم تتقبل القيادة السعودية الانتقادات الأميركية التي جرى التعبير عنها ـ ولو بشكل خجول ـ عن قمع السلطات البحرينية المدعومة سعودياً ضد الاحتجاجات السلمية التي تقوم بها الغالبية الشيعية. ويشعر السعوديون بالمزيد من الاحباط ازاء المواقف التي تتخذها إدارة أوباما، ووجدوا فيها دليلاً اضافياً على أن هذه الادارة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية البحرين بالنسبة للسعودية التي تقع على مرمى حجر من المنطقة الشرقية، عبر جسر الملك فهد، الذي لا يتعدى طوله الـ25 كلم.
في غضون ذلك، لم تُفضِ مرحلة ما بعد إطاحة مبارك إلى نوع من التفاهم بين السعوديين والأميركيين حول مصر، بل على العكس من ذلك وجد الطرفان أنهما يقفان في موقعين متضادين تماما، إلى حد أن مجموعة «ستراتفور للدراسات الاستخبارية» وضعت الخلاف بين البلدين بشأن الأزمة المصرية في موقعٍ يمثل خروجاً كبيراً للمملكة على السياسة الأميركية والاتجاه التاريخي. فقد تفاجأت الرياض بدعم ادارة أوباما لحكومة «الاخوان المسلمين» بعد سقوط مبارك واعتبرته بمثابة الخطيئة الكبرى، نظراً لما يشكله صعود جماعة «الاخوان المسلمين» إلى الحكم من خطر على النظام الملكي السعودي نفسه، لوجود قوى أصولية في المملكة تؤيد «الاخوان المسلمين» من جهة، ومن جهة أخرى، يشكل حكم «الاخوان المسلمين» في مصر تحدياً للسعوديين بتقديمهم تفسيراً مختلفاً للإسلام، بل إن دنيس روس المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي يعتبر «أن السعودية لها عَدُوَّانِ رئيسيَّانِ في المنطقة هما: الاخوان المسلمون وإيران».
لذا لم يكن من المستغرب أن تبادر الرياض وحلفاؤها من دول الخليج إلى الوقوف بقوة لدعم الحكومة المصرية الموقتة، وحين ألغت واشنطن المناورات العسكرية مع القاهرة نتيجة إطاحة مرسي، وعلّقت مساعدتها العسكرية لمصر البالغ قيمتها 1,3 مليار دولار، لم يتأخر السعوديون وحلفاؤهم الخليجيون في ضخ مليارات من الدولارات، تجاوزت 12 ضعفاً من قيمة المساعدة الأميركية المقررة لمصر.
وحدها سوريا من بين دول «الربيع العربي» في المشرق حظيت الاحتجاجات السلمية فيها منذ بداياتها بالمباركة والتشجيع من الرياض، خلافاً لفتاوى علماء الدين السعوديين بتحريم التظاهرات بالأساس، وهذا ما جرى الترويج له على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام السعودية، وكان الهدف من هذه الحملة نزع الشرعية عن التحركات الشعبية التي انطلقت سواءٌ داخل المملكة أم في خارجها في البحرين واليمن ومصر وتونس، تحت دعاوى أن هذه التظاهرات تتسبب بالفوضى وتؤدي إلى تخريب الأملاك الخاصة والعامة. ومع تحوّل الاحتجاجات السلمية في سوريا إلى تمرد عسكري، كانت المملكة في مقدمة البلدان التي دعمت هذا الخيار وتبنت الدعوة علناً لإطاحة نظام الأسد بالسبل العسكرية.
لا يجد المرء صعوبة في التعرف على سر الحماسة السعودية للعمل بكل قوة ضد النظام في سوريا؛ فقد وجدت القيادة السعودية في ما يجري في هذا البلد فرصة تاريخية لتعويض خساراتها المتعاقبة طيلة العقد الماضي، وتحديداً ما اعتبرته خسارة استراتيجية في العراق لمصلحة ايران، وان من شأن إحداث تغيير في سوريا أن يقلب المعادلة الاقليمية فتخسر إيران نقطة ارتكاز مهمة تؤثر في تواصلها مع «حزب الله» في لبنان وحركات المقاومة في فلسطين، والأهم من ذلك في حسابات السعوديين، أنهم لن يكونوا وحدهم في المواجهة مع نظام الأسد، بل إن عدداً من الدول الاقليمية والدول الغربية وفي طليعتها الولايات المتحدة ستكون إلى جانبهم، ناهيك عن أن الاصطفاف السعودي في مواجهة من هذا النوع من شأنه تحريك عصبية كتلة مهمة في الداخل السعودي ووقوفها مع الأسرة المالكة تحت شعارات طائفية: «دعم الغالبية السنية في سوريا ضد حكم الأقلية العلوية»، إلى حد أن الشيخ صالح اللحيدان الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء والمستشار الحالي في الديوان الملكي صرّح (إن لم نقل أفتى) في بدايات الحراك السوري بأنه يجوز قتل الثلث من الشعب السوري (قرابة ثمانية ملايين) من أجل إنقاذ الثلثين.
وجدت القيادة السعودية في تهديد الرئيس أوباما ضد نظام الأسد في قضية الهجوم الكيميائي في ضواحي دمشق (آب الماضي)، الفرصة السانحة لانخراط عسكري أميركي مباشر لإطاحة النظام في سوريا، وعلّقت آمالاً واسعة على المدى الذي سيصل إليه الرئيس أوباما، وبقدر هذه الآمال كان الإحباط والمرارة لدى السعوديين حين أبرم الأميركيون والروس اتفاقاً يلتزم بموجبه النظام في سوريا بالتخلص من ترسانته الكيميائية. هنا تبدو الخسارة السعودية مزدوجة، فالاتفاق حول الكيميائي لم يشكل طوق نجاة للنظام في سوريا من الضربة الأميركية فحسب، بل جعل منه شريكاً دولياً بوصفه الطرف المحلي الذي سيشرف على تنفيذ الاتفاق، بعد أن اشتد الخناق عليه في المرحلة السابقة من الصراع، وبات منبوذاً من مجموعة لا بأس بها من الدول الغربية والاقليمية، وهؤلاء كانوا يضعون رحيل الرئيس بشار الأسد كشرط أول للشروع بحل الأزمة السورية.
ومع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق في جنيف (24 تشرين الثاني) حول البرنامج النووي الايراني بين مجموعة دول (5+1) وإيران بلغ الإحباط السعودي تجاه ادارة أوباما مداه الأقصى. وهنا لا يتعلق الأمر بتوقيع الاتفاق فحسب، بل بالطريقة التي أبرم من خلالها، إذ جرى التحضير له بسرية تامة من خلال اطلاق مسار تفاوضي جانبي جمع مندوبين أميركيين مع نظرائهم الايرانيين عبر جولات متعددة استمرت قرابة الثمانية أشهر قبل توقيع الاتفاق في جنيف. ولعلّ ما أثار حنق القيادة السعودية وفاقم من شعورها بالمرارة، أنها وجدت نفسها مثل الزوج المخدوع، إذ إن العملية التفاوضية السرية بين الأميركيين والايرانيين تمت من وراء ظهرهم. والأنكى من ذلك، أن وقائع هذه المفاوضات جرت على مقربة منهم وبالتحديد في عُمان، هذا البلد الذي يعتبر شريكاً لهم كعضو مؤسس في مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك، لا الحليف الأميركي ولا الشريك الخليجي كلّفا نفسيهما عناء إطلاع السعوديين على حقيقة ما يجري من مفاوضات، وتم التعامل معهم مثلهم مثل غيرهم من البلدان الأخرى.
السفير