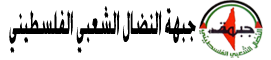دنفر– كان رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما محقاً عندما امتنع عن الذهاب إلى اجتماع التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والباسيفيكي في بالي بإندونيسيا، وفضل التركيز بدلاً من ذلك على التعامل مع الأمراض السياسية التي ابتلي بها الكونغرس الأميركي. ولكن، رغم صواب القرار، فإنه كان سبباً في إحياء التساؤل الذي أصبح شائعاً على نحو متزايد في منطقة شرق آسيا: ماذا حدث لـ”المحور”؟
الواقع أن محور أميركا الاستراتيجي الذي كثر الحديث عنه والذي اعتُبِر تحولاً طال انتظاره في الموارد والاهتمام، بعيداً عن الحروب وغيرها من التحديات الملحة في الشرق الأوسط ونحو الفرص الرحبة المتاحة في منطقة آسيا والباسيفيكي، سرعان ما اصطدم بالعقبة المتمثلة في العواقب غير المقصودة (الناجمة عن السياسات المتضاربة وغير الواضحة).
بادئ ذي بدء، كان هناك تصور مفاده انسحاب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان يعني تراجع أهمية مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ولأن ذلك جاء في عشية الربيع العربي المأساوي، فقد ناضلت إدارة أوباما ضد هذه النتيجة غير المقصودة لهذا المحور منذ ذلك الحين. ومن الواضح أن عبارة “القيادة من الخلف”، أياً كان الشخص الذي ابتكرها في الإدارة الأميركية، لم تسفر إلا عن زيادة المشكلة تعقيداً على تعقيدها.
ثانيا، تصور العديد من الأوروبيين أن تعديل المحور باتجاه آسيا يعني ضمناً تراجع التزام أميركا بتحالف الأطلسي. ورغم أن أداء العديد من البلدان الأوروبية كان طيباً نسبياً من حيث الحفاظ على مشاوراتها والتزاماتها تجاه الولايات المتحدة، فإن زعماء أوروبا كانوا يراقبون بقلق متزايد البنية الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب وهي تتهاوى.
لا شك أن الأوروبيين أسهموا في هذه الديناميكية: والشاهد على ذلك تسرعهم في إنهاء مهمة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان. ولكن الشعور المتزايد بانجراف البنية الأوروبية الأطلسية، والذي تغذى في الأساس على الأزمة المالية في أوروبا والصدع السياسي الذي طال أمده في أميركا، لا يترك مجالاً كبيراً للتفاؤل.
وأخيرا، كانت الجهود المبذولة لشرح أهداف هذا التحول -تأكيد الولايات المتحدة أن آسيا الآن أصبحت في مركز الاقتصاد العالمي- كانت عقيمة منذ البداية. وتصور الصينيون أن الغرض من التحول بالكامل كان مواجهة واحتواء صعود بلادهم على الصعيد الجيوسياسي. ومن يستطيع أن يلومهم بعد طبول الحرب التي دقتها تصريحات الولايات المتحدة التي أعربت عن قلقها إزاء الصين.
الواقع أن عادة تقريع الصين من قِبَل المسؤولين الأميركيين تفاقمت سوءاً في الأسابيع التي أعقبت الإعلان الأولي عن المحور (والذي جاء في خضم حملة الانتخابات الأميركية في العام 2012). وتحول التمديد الطبيعي تماماً للاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والفلبين إلى مناسبة للولولة والتحسر إزاء مزاعم الصين في المطالبة بما وصفته وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بـ”بحر الفلبين الغربي“.
في هذه البيئة، اعتبر الصينيون القرار الروتيني بإرسال مشاة البحرية الأميركية إلى التدريب في أستراليا حلقة أخرى من حلقات السلسلة المقصود منها تكبيل الصين. وحتى الانفتاح على ميانمار وصل إلى الصحافة باعتباره تحركاً مصمماً لمواجهة النفوذ الصيني في ذلك البلد الغني بالموارد.
وبعد فترة وجيزة من هذه الأحداث، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها تعتزم البدء في إعادة نشر القوات الأميركية إلى الغرب من منطقة الباسيفيكي، الأمر الذي أدى إلى تركيز اهتمام الصينيين على الأمر. وعلى نحو مماثل، كان اتفاق الشراكة عبر المحيط الباسيفيكي -اتفاقية التجارة الحرة العملاقة المقترحة والتي استبعدت الصين منها حتى الآن- سبباً في تغذية المخاوف في الصين بشأن نوايا الولايات المتحدة.
بيد أن الصين لم تكن بريئة من اللوم: والشاهد على ذلك نهجها الغليظ الأخرق تجاه جيرانها في آسيا من خلال تأكيد مطالباتها الإقليمية ببحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي. وفي حين كانت إشارات نفاد الصبر إزاء كوريا الشمالية موضع ترحيب باعتبارها نذيراً لتحول سياسي في نهاية المطاف، فإن الفكر الجديد في الصين لم يكن كافياً لإحباط جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تعزيز التعاون العسكري مع كوريا الجنوبية واليابان.
ولكن، ربما لا تحتاج الصين إلى القيام بأي شيء لتغيير سياسة الولايات المتحدة مرة أخرى. فمنذ إعادة انتخاب أوباما، شهدنا تحولاً عن المحور الجديد، نحو شيء يمكن وصفه بالمزاج الرجعي العتيق. والواقع أن الجهود التي بذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدفع عملية السلام العربية الإسرائيلية كانت مبادرة محمودة، ولكن إذا كنا تعلمنا من الربيع العربي أي شيء فهو أن خطوط الصدع الحقيقية في الشرق الأوسط لا تتعلق بإسرائيل بقدر ما تتصل بالانقسام العلماني الإسلامي المتزايد العمق في العالم العربي والصراع الطائفي المتنامي بين الشيعة والسُنّة. ولا تشكل إسرائيل سوى جزءاً ضئيلاً من هذا النمط العام.
شهدنا مؤخراً تحول أميركا في استجابة للأحداث نحو التعاون مع روسيا بشأن إنهاء الحرب الأهلية في سورية، في أعقاب الهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي أسفر عن مقتل 1400 شخص على الأقل.
وكل هذا يثير تساؤلاً جوهرياً: هل تحتاج الولايات المتحدة حقاً إلى تصميم شامل لسياستها الخارجية؟ إذا كانت النتيجة هي جعل سياستها الخارجية أقل جدارة بالثقة وأقل توقعاً -أو عُرضة لسوء الفهم- فمن المؤكد أنها لا تحتاج إلى ذلك.
لقد أفسح النظام العالمي الجديد المجال لعالم بلا نظام، حيث انحسرت المصداقية والثبات على المبادئ لتحل محلها تحولات سريعة في التركيز والتزامات متقلبة. ومن المحزن أن هذه الحال تبدو وكأنها ليست نابعة من بلدان تعاني من أزمة، بل من الولايات المتحدة ذاتها.
الآن، بعد أن تسنى لأوباما الحصول على راحة قصيرة من مشاكله الداخلية، فإن الفرصة قد تكون سانحة له الآن لإعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية الأميركية وشرح الكيفية التي تخطط بها الولايات المتحدة لملاحقة هذه الأولويات. هل يصلح محور آسيا للاستمرار؟ وما الأهداف الأميركية في الشرق الأوسط؟ وهل تصبح الولايات المتحدة أشبه بمنظمة غير حكومية متغطرسة، فتحاضر في أصدقائها وخصومها على السواء لأنهم ليسوا أكثر تشبهاً بأميركا؟ وما هو على وجه التحديد الذي تحاول الولايات المتحدة تحقيقه في روسيا؟ وهل يكون بوسعها أن تحدد سبل التعاون مع هذه الدولة الصعبة غير الديمقراطية، من أجل معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك؟
لقد حان الوقت لكي يعيد أوباما النظر في سياسة أميركا الخارجية عموما. فإدارته ما تزال على مسافة ثلاث سنوات من نهاية ولايتها، والعالم ينتظر ويراقب، وبصراحة “يتعجب“.
كريستوفر ر. هِل
*هو مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون شرق آسيا، وعميد كلية كوربل للدراسات الدولية في جامعة دنفر حاليا.
*خاص بـ “الغد”، بالتعاون مع “بروجيكت سنديكيت”، 2013.