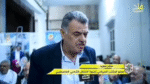أمد/ هناك اهتمام واسع بنتائج اجتماع دونالد ترمب مع شي جينبينغ في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع تأثيرها المحتمل على العلاقات الصينية- الأميركية في الأقل خلال الأعوام المتبقية من ولاية ترمب، المؤشرات تعكس رغبة الجانبين في ضبط الأمور بتخفيف التوتر والمضي قدماً بحساب.
يتم تسليط الأضواء على نقاط القوة والضعف الآنية للطرفين، خصوصاً بعد توسع ترمب في استخدام سلاح الجمارك والضرائب، ومنها وقف الصين شراء فول الصويا الأميركي، وسيطرتها على المعادن الأرضية النادرة الثقيلة، والأساسية في إنتاج أشباه الموصلات، وأنظمة الأسلحة، والسيارات، وحتى الهواتف الذكية، في حين يدرك ترمب أن الصين تواجه تحديات اقتصادية دولية ومحلية متزامنة من شأنها أن تضعف رغبتها في خوض معركة اقتصادية واسعة، خصوصاً إذا استؤنف تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتراجعت أميركا عن دعمها العسكري لتايوان.
قمت بزيارة الصين بانتظام على مدار العقد الماضي تقريباً، باستثناء فترة جائحة “كوفيد-19″، بما في ذلك ثلاث مرات منذ أوائل صيف عام 2025. كانت المناقشات ذات طابع جيوسياسي عالمي، وانصبت مساهماتي بشكل رئيس على النظام العالمي والشرق الأوسط، لكن العلاقات مع الولايات المتحدة كانت محل اهتمام كبير بين الصينيين والأميركيين. ومن ثم، شعرت بضرورة التعمق في العلاقات الصينية- الأميركية.
العلاقات الأميركية- الصينية: “عدائية أم تنافسية؟” مما يختلف إلى حد كبير على المجال الذي يدرس الأمن أو الاقتصاد أو التكنولوجيا أو الأيديولوجيا. في الواقع الإغلاقات بين البلدين مزيج معقد من الاثنين: تنافسي في جوهره، ولكنه غالباً ما يتحول إلى سلوك عدائي عندما يكون الأمن القومي والهوية السياسية على المحك.
تعرف “الاستراتيجية الأمنية” الوطنية للولايات المتحدة لعام 2022 الصين بأنها “المنافس الوحيد الذي يمتلك النية، وبشكل متزايد، القدرة على إعادة تشكيل النظام الدولي”. يمثل هذا تطوراً حاسماً عن الصياغات السابقة التي ركزت على المشاركة والتكامل. تؤكد الاستراتيجية ضرورة “التفوق على الصين” في التكنولوجيا، والنفوذ الاقتصادي، والاستعداد العسكري.
وتكرر استراتيجية الدفاع الوطني لـ”البنتاغون” هذا، حيث تسمي الصين “تحدي تحديد وتيرة التقدم” لأميركا، معيار التحديث العسكري والتخطيط الاستراتيجي. لقد اتفقت الإدارات الأميركية المتعاقبة -من “التوجه نحو آسيا” لأوباما إلى “المنافسة الاستراتيجية” لترمب ودعوة بايدن إلى “تخفيف الأخطار، وليس فك الارتباط”، على إجماع أساسي: لم تعد الصين شريكاً في العولمة، بل منافساً منهجياً.
لغة بكين الرسمية أكثر دبلوماسية ولكنها بالقدر نفسه من الوضوح في النية. تؤكد الأوراق البيضاء الصينية “للأمن” والدفاع الوطني على حماية السيادة والسلامة الإقليمية و”التجديد الكبير للأمة الصينية”. تصور هذه الأوراق الولايات المتحدة على أنها تحاول احتواء صعود الصين، والتدخل في الشؤون الداخلية (بخاصة تايوان وهونغ كونغ وبحر الصين الجنوبي)، مما يؤدي إلى إدامة عقلية الحرب الباردة. ومع ذلك تصر هذه الوثائق أيضاً على أن الصين “لا تسعى إلى الهيمنة” وتدعم “مجتمعاً ذا مستقبل مشترك للبشرية”، مما يعكس النية السلمية مع تبرير الحزم الاستراتيجي.
منذ تسعينيات القرن الماضي، اتسمت العلاقات الأميركية- الصينية إلى حد كبير بالمشاركة والاعتماد المتبادل. رحبت واشنطن بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية (2001) وافترضت أن التكامل الاقتصادي يشجع الاعتدال السياسي. بدأت الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتصاعد القومية الصينية، وتزايد قلق الولايات المتحدة بشأن سرقة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في تغيير النبرة.
وخلال العقد الأول من القرن الـ21، جسدت النزاعات التجارية والعقوبات والجدل حول هواوي انعدام ثقة أعمق، كما أدت جائحة “كوفيد-19” والاتهامات المتبادلة بالتضليل إلى تصلب المواقف. واليوم، تشمل الأجندة الثنائية المنافسة في جميع المجالات الاستراتيجية، الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية والأيديولوجية.
في “المجال الاقتصادي”، تهيمن المنافسة، لكن النزعات العدائية آخذة في الازدياد. فرضت الولايات المتحدة ضوابط تصدير على أشباه الموصلات المتقدمة، وشددت مراجعات الاستثمار الأجنبي، وسعت إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية في قطاعات حيوية مثل المعادن النادرة والأدوية. ردت بكين بقانونها الخاص لمكافحة العقوبات الأجنبية، وفرضت قيوداً على صادرات المعادن الأساسية، وبذلت جهوداً لتسريع الاعتماد على الذات في إطار استراتيجية “التداول المزدوج”.
تعد الهيمنة التكنولوجية محورية. تسعى واشنطن إلى الحفاظ على تفوقها الابتكاري من خلال تشكيل تحالفات مثل تحالف “شيب 4” (مع اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان)، بينما تهدف خطة “صنع في الصين 2025” الصينية إلى تحقيق الريادة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء. ينظر كل جانب إلى الاعتماد التكنولوجي على أنه نقطة ضعف استراتيجية، وهو موقف يحول المنافسة الاقتصادية إلى صراع شبه أمني.
يعد البعد العسكري المكان الذي تقترب فيه المنافسة من السلوك العدائي بشكل وثيق. تحافظ الولايات المتحدة على تحالفات وشراكات من خلال استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ، والرباعية (مع اليابان والهند وأستراليا)، وتحالف “أوكوس” (مع المملكة المتحدة وأستراليا)، المصممة لردع الحزم الصيني، لا سيما في ما يتعلق بتايوان وبحر الصين الجنوبي. وسعت الصين أسطولها البحري، وحصنت جزراً اصطناعية، وحدثت ترسانتها النووية، وأجرت تدريبات عسكرية متكررة قرب تايوان. تبدو الإجراءات الدفاعية لكل جانب مسيئة للآخر.
يعمق الاختلاف في “الفلسفة الاستراتيجية” سوء الفهم. فالفكر الصيني التقليدي، الذي يجسده كتاب “فن الحرب” للمفكر كون تزو، يقدر الصبر والخداع والميزة غير المباشرة – الفوز من دون قتال. يؤكد هذا النهج استراتيجية بكين طويلة المدى: التأثير التدريجي من خلال التجارة والدبلوماسية والنفوذ الاقتصادي بدلاً من المواجهة العلنية.
على النقيض من ذلك، غالباً ما تعكس “الثقافة الاستراتيجية” الأميركية منطق “فن الصفقة”، فترمب يركز على النفوذ والقوة الظاهرة والتفاوض القائم على الصفقات، ينتج هذا أسلوباً أكثر فورية ومدفوعاً بالنتائج، يسعى إلى تحقيق مكاسب سريعة وملموسة، مع تباين وتفاعل العقليتين، إحداهما خفية والأخرى علنية، تتضاعف المفاهيم الخطأ. قد ترى واشنطن التدرج الصيني تلاعباً، وقد ترى بكين الصراحة الأميركية استفزازاً.
تشكل “الأيديولوجيا” أيضاً التنافس، فقبل ترمب، عرفت الولايات المتحدة نفسها لفترة طويلة بأنها المدافعة عن الديمقراطية الليبرالية والنظام القائم على القواعد، بينما ينظر الحزب الشيوعي الصيني إلى هذا الإطار كأداة غربية للسيطرة. أحيت قيادة شي جينبينغ التركيز الماركسي اللينيني على سيادة الحزب والانضباط الأيديولوجي، بينما يصف المسؤولون الأميركيون بشكل متزايد المنافسة بأنها بين “الديمقراطية والاستبداد”.
تعزز السياسة الداخلية هذا الانقسام. ففي الولايات المتحدة، ازداد التشكيك الحزبي تجاه الصين، حيث أيد الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء مواقف أكثر صرامة في التجارة والأمن وحقوق الإنسان. أما في الصين، فتؤكد القومية وروايات الإذلال التاريخي أن الوقوف بحزم في وجه الضغوط الأميركية أمر لا غنى عنه سياسياً.
لذلك، يخاطب كل جانب جمهوره المحلي بقدر ما يخاطب الآخر، مما يضيق مجال التسوية.
ومع ذلك وعلى رغم تزايد الاحتكاك، يدرك كلا الجانبين أن الصراع المفتوح سيكون كارثياً. لا تزال اقتصاداتها مترابطة: فالصين هي أكبر شريك تجاري لأكثر من 120 دولة، بمن في ذلك حلفاء رئيسون للولايات المتحدة، بينما تظل الولايات المتحدة الوجهة الرئيسة لصادرات الصين ومصدراً للتكنولوجيا والتمويل. ولا تزال التحديات العالمية، تغير المناخ والأوبئة والاستقرار المالي ومنع الانتشار النووي، تتطلب التعاون.
وهكذا، أصبحت المنافسة المدارة هي الشعار. تتحدث واشنطن عن “حواجز أمان”، بينما تدعو بكين إلى “الاحترام المتبادل والتعايش السلمي”، لكن انعدام الثقة متأصل، وحتى الجهود التعاونية تنظر إليها من منظور تنافسي.
تمثل العلاقات الأميركية- الصينية اليوم مزيجاً من المنافسة الدائمة مع اندلاع عدائي دوري، يحدها الردع المتبادل، والترابط الاقتصادي، والوعي المشترك بأن المنافسة حتمية، لكن الصراع المباشر سيكون هزيمة ذاتية.
كما نصح صن تزو، “إن أسمى فنون الحرب هو إخضاع العدو من دون قتال”. وكما تضيف البراغماتية الأميركية، فإن أفضل صفقة هي تلك التي تترك كلا الجانبين صامدين. سيعتمد مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين على مدى قدرة قادتها على التوفيق بين هاتين الفلسفتين.
عن اندبندنت عربية